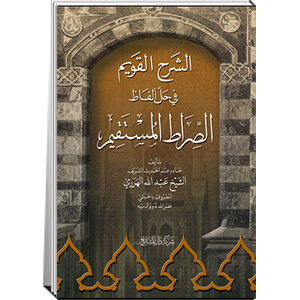 قال المؤلف رحمه الله: مَعْنَى القَدَرِ والإيمانِ به
قال المؤلف رحمه الله: مَعْنَى القَدَرِ والإيمانِ به
قَالَ بَعْضُ العُلَماءِ: القَدَرُ هُوَ تَدْبيرُ الأَشْياءِ علَى وجْهٍ مُطَابِقٍ لِعِلْمِ الله الأزَليّ ومَشِيئَتِه الأزَليَّةِ فيُوجِدُها في الوَقْتِ الذي عَلِمَ أَنَّها تَكُونُ فيه.
الشرح: إيجادُ الله الأشياءَ على حَسَبِ ما سَبَقَ في علمِهِ الأزليّ وإبرازُها في الوجودِ على حَسَبِ مشيئتهِ الأزليَّةِ يُسمَّى قَدَرًا، ويقالُ بعبارةٍ أخرى: القدرُ هو جَعلُ كلّ شىءٍ على ما هُوَ عليه.
وليُعلَم أن القدَر يُطلقُ ويرادُ به صفة الله أي التّدبير ويطلقُ ويرادُ به المقدور أي المخلوق وهذا هو المقصودُ بحديثِ جبريلَ: "وبالقَدَرِ خيرِهِ وشَرّهِ"، لأن المقدورَ هو الذي يوصفُ بالخيرِ والشر.
قال المؤلف رحمه الله: فَيدخُلُ في ذَلِكَ عَمَلُ العَبْدِ الخَيْرَ والشَّرَّ باختِيَارِه.
الشرح: الإنسانُ إذا عَمِلَ حسنةً يُسمَّى عَمَلُهُ خيرًا، وإن عَمِلَ الإنسانُ معصيةً يسمَّى عملهُ شرًّا وكلاهما بخلقِهِ تعالى، أما الله تعالى تقديرهُ لا يُسمَّى شرًّا، تقديرُهُ حسنٌ ليس فيه شرٌّ.
أما فعلُ العبدِ للقبيحِ قبيحٌ من العبدِ وأما تقديرُ الله للقبيحِ ليس قبيحًا من الله، وكذلك خلقُهُ للقبيحِ ليس من الله قبيحًا كما أن إرادَتَه لوجودِ الشر ليست قبيحةً منه.
قال المؤلف رحمه الله: ويَدُلُّ علَيه قولُ رَسُولِ الله إلى جِبْريلَ حِينَ سَأَلَهُ عن الإيمانِ: "الإيمانُ أنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلائِكتِه وكتُبِه ورُسُلِهِ واليَوم الآخِرِ وتُؤمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِه وشَرّه" رواه مسلم. ومَعْنَاهُ: أنَّ المَخْلُوقَاتِ التي قَدَّرَها الله تَعالى وفيها الخَيرُ والشَّرُّ وُجِدَت بتَقْديرِ الله الأزليّ، وأمَّا تَقْدِيرُ الله الذي هُوَ صِفَةُ ذاتِهِ فَهُوَ لا يُوصَفُ بالشَّرّ بل تقديرُ الله للشرِ الكفر والمعصية وتقديرُه للإيمانِ والطاعةِ حسنٌ منه ليس قبيحًا.
الشرح: أن معنَى قوله عليه السلام في حديثِ جبريل: "الإيمانُ أن تؤمِنَ بالله وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ واليومِ الآخر وتؤمن بالقدرِ خيرِهِ وشرّه" أي اعتقاد أن المقدوراتِ كلَّها بتقديرِ الله تكونُ أي بإيجادِهِ إياها، فالطاعةُ التي تحصُلُ من المخلوقين والمعصيةُ التي تحصُلُ منهم كلٌّ بخلقِ الله وإيجادِهِ إياها، وذلك لأن تقديرَ الله الذي هو صفتُهُ حسنٌ لا يوصَفُ بأنه شرٌّ.
قال المؤلف رحمه الله: فإرادةُ الله تعالى نَافِذَةٌ في جميعِ مُرَادَاتِهِ على حَسَبِ عِلمِهِ بها.
الشرح: إرادةُ الله أي مشيئتُهُ نافذةٌ لا تَتَخَلَّفُ ليست كمشيئةِ العبادِ، مشيئةُ العبادِ تتنفَّذُ في بعض الحالاتِ ولا تتنفَّذُ في بعض الحالاتِ، أما الله تعالى فمشيئتُهُ نافذةٌ في كلّ مُرَادَاتِهِ، وهذا معنى ما أجمعَ عليه المسلمونَ: "ما شاءَ الله كانَ وما لم يشأ لم يَكُن".
قال المؤلف رحمه الله: فما علِمَ كَونَهُ أرادَ كونَه في الوقتِ الذي يكونُ فيه، وما عَلِمَ أنَّه لا يكونُ لم يُرِدْ أن يكون.
الشرح: ما عَلِمَ الله في الأزلِ أنه يكونُ فقد شاءَ كونَهُ فلا بدَّ أن يكونَ، فأعمالُنَا التي سَبَقَ في علمِ الله أنها تكونُ شاءَ أن تكونَ فلا بدَّ أن تكونَ، وأما ما لم يشأ الله تعالى أن يكونَ فلا يكونُ.
قال المؤلف رحمه الله: فلا يَحدُثُ في العالم شىءٌ إلا بمشِيئتِهِ ولا يُصيبُ العبدَ شىءٌ من الخيرِ أو الشرّ أو الصحةِ أو المرضِ أو الفقْرِ أو الغِنى أو غيرِ ذلك إلا بمشيئةِ الله تعالى، ولا يُخطئ العبدَ شىءٌ قدَّرَ الله وشاءَ أن يصيبَهُ، فقد وَرَدَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ بعضَ بناتِهِ: "ما شاءَ الله كانَ وما لم يشأ لم يَكُن" رواهُ أبو داودَ في السُّنَنِ ثمَّ تَواتَرَ واستفاضَ بين أفرادِ الأمَّةِ.
الشرح: مشيئةُ الله شامِلَةٌ لأعمالِ العبادِ الخيرِ منها والشَّرّ، فكلُّ ما دَخَلَ في الوجودِ من أعمالِ الشَّرّ من كُفرٍ أو معصيةٍ فبمشيئَةِ الله وَقَعَ وحَصَلَ، وهذا كمالٌ في حقّ الله تعالى لأن شمولَ القدرةِ والمشيئةِ لائقٌ بجلالِ اج، فلو كانَ يَقَعُ في ملكِهِ ما لا يشاءُ لكانَ ذلك مُنَافيًا للألوهيَّةِ. أما ما رواهُ أبو داودَ في سننهِ فقد أجمعَ المسلمون عليهِ.
قال المؤلف رحمه الله: وَرَوى البيهقيُّ رحمَه الله تعَالى عن سيّدِنا عَليٍّ رضيَ الله عنْه أنَّه قالَ: "إنَّ أحَدَكُم لَنْ يَخْلُصَ الإيمانُ إلى قَلبِه حتّى يَستَيْقِنَ يَقِينًا غَيْرَ شَكٍّ أنَّ مَا أصَابَه لم يَكُن لِيُخطِئَهُ ومَا أخطأَهُ لم يكن لِيُصِيبَهُ، ويُقِرَّ بالقَدَرِ كلِّهِ". أيْ لا يَجوزُ أن يُؤْمنَ ببعْض القَدَرِ ويَكْفُرَ ببعضٍ.
الشرح: معنى هذا الأثر عن سيّدنا عليّ رضي الله عنه أنه لا يتمُّ الإيمان في قلب أحدكم حتى يستيقن يقينًا غير شكّ أي حتى يعتقد اعتقادًا جازمًا لا يخالجه شكٌّ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه إن كان من الرّزق أو المصائب أو غير ذلك وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقرَّ بالقدر كلّه، معناه لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعضٍ بل يجب على كلّ مسلم أن يؤمن بأن كلَّ ما يجري في الكون من خيرٍ أو شرّ ضلالةٍ أو هدى عسرٍ أو يسرٍ حلوٍ أو مرٍّ كلُّ ذلك بخلق الله ومشيئته حدث وكان ولولا أن الله تعالى شاءه وكوَّنه وخلقه ما حصل.
قال المؤلف رحمه الله: ورَوَى أيْضًا بالإسْنادِ الصّحيحِ أنَّ عمرَ بنَ الخَطّاب كانَ بالجَابيةِ - وهي أرْضٌ من الشَّام - فقامَ خطيبًا فَحَمِدَ الله وأثْنَى عليه ثمَّ قالَ: "من يَهْدِ الله فلا مُضِلَّ لهُ ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ"، وكان عندَهُ كافرٌ من كفّارِ العجَم من أهْلِ الذّمّةِ فقال بلُغَتِهِ: "إنَّ الله لا يُضِلُّ أحدًا"، فقالَ عُمَرُ للتَّرجُمان: "ماذا يقولُ"؟ قال: إنّه يقولُ: إنّ الله لا يُضِلُّ أحدًا، فقالَ عمرُ: "كذَبتَ يا عَدُوَّ الله ولَولا أنَّكَ من أهل الذّمّةِ لضَرَبتُ عنُقَكَ هُوَ أضَلَّك وهُوَ يُدخِلُكَ النَّارَ إن شاءَ".
الشرح: مَعنى كلام عمرَ رضي الله عنه أن هذا الاعتقاد كفرٌ وضلالٌ وهو اعتقادُ أن الله لا يُضِلُّ أحدًا أي أن الإنسانَ يضلُّ بمشيئتِهِ لا بمشيئَةِ الله، وأن العبدَ هو يَخلُقُ هذه الضلالةَ ليس الله خالقَهَا.
ومعنى قول سيدنا عمر: "إن شاءَ" أي إن شاءَ أن تموتَ على كفرِكَ هذا لا بُدَّ من دخولِك النار. وقد احتجَّ سيدنا عمر بهذه الآية: ﴿وَمَن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ﴾ [سورة الزمر/37] ومعناهُ أن الذي شاءَ الله له في الأزلِ أن يكون مهتديًا لا أحد يجعلهُ ضالا، ﴿مَن يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ﴾ [سورة الأعراف/186] أي ومَن شاءَ الله أن يكون ضالا فلا هادِيَ لهُ، أي لا أحد يهديه ولا أحد يجعلهُ مهتديًا. وهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنذرَ قومَهُ أوَّل ما نزلَ عليه الوحيُ عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ [سورة الشعراء/214] أي حذِّرهم من الكفرِ ثم اهتدَى به أناسٌ ولم يهتد به أناسٌ حتى من أقاربِهِ كأبي لهبٍ وغيرِه فإنهم لم يهتدوا، والرّسولُ بلَّغهم دعوتَهُ لكن لم يهتدوا، وأولئكَ الذين اهتدوا اهتدوا، فما هو الموجِبُ لذلك أي لأن يهتديَ هؤلاءِ ولا يهتدي هؤلاءِ؟ الموجبُ لذلكَ أن الله تبارك وتعالى شاءَ في الأزلِ أن يهتديَ هؤلاء بمحمدٍ ولم يشأ أن يهتديَ الآخرونَ تنفَّذت مشيئةُ الله في الفريقينِ.
والله تعالى يكرَهُ الكفرَ والمعاصي لكن خصَّصَ هؤلاء بأن ينساقوا إلى الضّلالِ، كما خصَّصَ أولئكَ بأن ينساقوا باختيارِهِم إلى الهُدَى، هذا معنى المشيئةِ.
قال المؤلف رحمه الله: وَرَوَى الحَافِظُ أبُو نُعَيْم عن ابنِ أخي الزُّهْرِيّ عن عمّه الزُّهريّ أنّ عُمرَ بنَ الخطابِ كان يحبُّ قصيدةَ لَبِيدِ بنِ رَبِيعَةَ التي مِنها هذِه الأبْياتُ، وهيَ:
إِنَّ تَقْوى ربّنَا خَيرُ نَفَلْ ***** وبإذنِ الله رَيْثي وعَجَلْ
أحمَدُ الله فَلا نِدَّ لهُ ***** بيَدَيْهِ الخيرُ ما شَاءَ فَعلْ
مَنْ هَداهُ سُبُلَ الخَيْرِ اهتَدى ***** ناعِمَ البَالِ ومَنْ شَاءَ أضَل
ومَعنى قولِه: "إِنَّ تَقْوى ربّنا خَيرُ نفَل"، أي خَيرُ ما يُعطاه الإنسانُ.
الشرح: هذه الأبياتُ من بَحرِ الرَّمَلِ وقد كان عمرُ يُعجبُ بها لما فيها من الفوائدِ الجليلة.
فقولُه: "إن تقوى رَبّنا خيرُ نَفَل" أي أنَّ تقوى الله خيرُ ما يؤتاهُ الإنسانُ وخيرُ ما يُعطَاهُ، والتَّقوى كلمةٌ خفيفةٌ على اللسانِ لكنها ثقيلةٌ في العملِ لأنها أداءُ ما افترضَ الله على العبادِ واجتنابُ ما حَرَّمَ عليهم، وهذا أمرٌ ثقيلٌ.
قال المؤلف رحمه الله: ومَعْنى قَولِه: "وبإذن الله رَيْثي وعَجَل"، أي أَنّه لا يُبطِئ مُبْطِئ ولا يُسْرِعُ مُسْرِعٌ إلا بمشِيئَةِ الله وبإذنِه.
الشرح: أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يُسرعُ نشيطٌ في العملِ إلا بمشيئَةِ الله وإذنِهِ، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يَخلُقُ في العبدِ القوَّةَ والنَّشاطَ للخيرِ، وهو الذي يخلُقُ فيه الكسلَ والتَّواني عن الخير، أي أن الخيرَ والشرَّ اللذين يحصلانِ من الخلقِ كلٌّ بخلقِ الله تعالى ومشيئتِهِ.
قال المؤلف رحمه الله: وقَوْلِه: "أحْمَدُ الله فَلا نِدَّ لَهُ"، أيْ لا مِثْلَ له.
وقولِه: "بيديه الخَيْرُ"، أيْ والشَّرُّ.
الشرح: أي أن الله تعالى مالكُ الخيرِ ومالكُ الشَّرّ لا خالقَ للخيرِ والشَّرّ من أعمالِ العبادِ إلا الله، ليسَ العبادُ يخلقونَهُ ولا النُّورُ ولا الظُّلمةُ يخلقانِ ذلك كما قالت المَانويَّةُ وهم قومٌ يقولونَ: النّورُ والظُّلمةُ قديمانِ أزليَّانِ ثم تمازَجَا فحدَثَ عن النّورِ الخيرُ وعن الظُّلمةِ الشرُّ وقد كذَّبهم المتنبّي الشَّاعرُ في قوله:
وكَم لظَلامِ الليلِ عِنْدِيَ مِنْ يَدٍ ***** تُخَبّرُ أنَّ المَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ
وإنما اقتصر لبيدُ بن ربيعة رضي الله عنه على ذِكرِ الخيرِ دون الشَّرّ اكتفاءً بذكرِ الخيرِ عن ذكر الشَّرّ لأنه معلومٌ عند أهلِ الحقّ أن الله خالقُ الخيرِ والشَّرّ وعلى هذا اتَّفَقَ أهلُ الحقّ، فإيمانُ المؤمنين وطاعاتُهم وكفرُ الكافرين كلٌّ بخلقِ الله تعالى ومشيئتِهِ، إلا أن الخيرَ الإيمانَ والطَّاعةَ بخلقِ الله ومشيئتِهِ ورضاهُ، والشرَّ أي الكفر والمعاصيَ بخلقِ الله يحصُلُ من العبادِ لا برضاهُ بل نهاهم عن ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يريدُ لا يُسأَلُ عما يفعلُ. ولا يجوزُ قياسُ الخالِقِ على الخَلقِ كالذي يقولُ كيف يكونُ خالق الشَّرّ فينا ثم يحاسبُنا في الآخرةِ على الشَّرّ، فقد قاسَ الخالقَ على الخلقِ وذلك ضلالٌ بعيدٌ، لا يتمُّ أمرُ الدّين إلا بالتَّسليمِ لله فمن سَلَّم لله سَلِمَ، ومن تَرَكَ التّسليمَ له فاعتَرَضَ لم يَسلَم.
فإن قيلَ أليسَ الله تبارك وتعالى قال: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ (26) اقتصرَ على ذكرِ الخيرِ ولم يَقُل والشَّرُ فكيف يجوزُ أن يقالَ إنه خالقُ الخيرِ والشرّ، فالجواب: في مواضعَ أخرى من القرءانِ ما يفيدُ أن الله تعالى خالقُ كلّ شىءٍ، والشّىءُ يشمَلُ الخيرَ والشرَّ قال الله تبارك وتعالى لنبيّه محمّدٍ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء﴾ [سورة ءال عمران/26] فَعَلِمنا من قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء﴾ (26) أنه هو خالقُ الخيرِ والشرّ لأنه هو الذي ءاتى أي أعطَى المُلكَ للملوكِ الكفرةِ كفرعونَ والملوكِ المؤمنينَ كذي القرنين، فليس في تَركِ ذكرِ الشرّ مع الخيرِ في قوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ (26) دليلٌ على أن الله تعالى لَيسَ خالقًا للشّرّ، وهذا عندَ علماءِ البيانِ يُسمَّى الاكتفاء أي تركَ ذكرِ الشىءِ للعلمِ به بذكر ما يقابله.
وأما قولُه تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [سورة النساء/79] فالحسنةُ معناها هنا النّعمةُ، والسَّيّئةُ هنا معناها المصيبةُ والبليَّةُ، فمعنَى الآية: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ﴾ (79) أي ما أصابَك من نعمةٍ فمن فضلِ الله عليكَ ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ (79) أي وما أصابَكَ من مصيبةٍ وبليَّةٍ فمن جزاءِ عملِكَ، أعمالُ الشرّ التي عملتَهَا نجازيكَ بها بهذه المصائبِ والبلايا، وليس المعنى أنكَ أنتَ أيها الإنسانُ تَخلُقُ الشَّرَّ، فالعبدُ لا يخلُقُ شيئًا لكن يكتسبُ الخيرَ ويكتسبُ الشَّرَّ والله خالقهما في العبدِ. وهذا التقريرُ معروفٌ عند كثيرين، وهناكَ تقريرٌ ءاخرُ للآية ينبغي أن يؤخَذَ بهِ ويُترَكَ التقريرُ السابِقُ وهو أن معنَى قوله تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ﴾ (79) محكيٌّ عن المشركينَ بتقدير محذوفٍ وهو: "يقولون أو قالوا" فيكونُ التقديرُ: يقولونَ أو قالوا لمحمدٍ ما أصابَكَ من حسنةٍ أي نعمةٍ فمنَ الله وما أصابَكَ من سيئةٍ أي مصيبةٍ فمنك يا محمدُ أي من شؤمِكَ، وهذا التقريرُ خالٍ عن الإشكالِ بخلافِ الأولِ فإن فيه إشكالا، وقد قال هذا التقريرَ علماءُ منهم السيوطيُّ الشافعيُّ والقونويُّ الحنفيُّ.
قال المؤلف رحمه الله: وإنَّما اقتَصَرَ على ذِكر الخَير من بابِ الاكتِفاءِ كقَولِه تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [سورة النحل/81]، أي والبردَ لأن السرابيلَ تقي منَ الأمرينِ ليسَ منَ الحرّ فقط.
الشرح: هذا في لغةِ العربِ يقالُ له أسلوبٌ من أساليبِ البلاغَةِ باللغةِ العربيةِ عند الفصحاءِ البُلغَاءِ وهو أن يُذكَرَ أحدُ الشيئين الداخلَين تحتَ حكمٍ واحدٍ اكتفاءً بأحدِهما عن ذكرِ الآخرِ كما في قوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة ءال عمران/26] فليس المعنَى أنه قادرٌ على الخيرِ فقط وليس قادرًا على الشَّرّ، وكما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ﴾ [سورة النحل/81] السَّرابيلُ هي القمصانُ، فقمصانُ الحديدِ الدُّروعُ التي تُلبَسُ في الحربِ هذه تقي من السّلاحِ، الله تعالى يمتنُّ علينا بأنه خَلَقَ لنا هذا وهذا، خلق لنا سرابيلَ تقينا الحَرَّ أي والبردَ وسرابيلَ أي قمصانًا أي أدراعًا من حديدٍ تقيكم بَأسَكُم أي السّلاح.
قال المؤلف رحمه الله: وقولِه: "ما شَاءَ فَعَل"، أي ما أرادَ الله حُصولَهُ لا بُدَّ أن يَحصُلَ وما أرادَ أن لا يَحصُلَ فَلا يَحْصُلُ.
وقولِه: "من هَداهُ سُبُلَ الخَيْرِ اهتَدَى"، أي من شَاءَ الله له أن يكونَ على الصّراطِ الصَّحيحِ المستَقيمِ اهتَدَى.
وقولِه: "ناعِمَ البالِ"، أي مُطمئنَّ البَالِ.
وقولِه: "ومَنْ شاءَ أضَلّ"، أي مَن شَاءَ له أن يكونَ ضَالا أضَلَّهُ.
الشرح: معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هَدَاهُ سُبُلَ الخيرِ أي من شَاءَ له في الأزلِ أن يكونَ مهتديًا على الصّراطِ الصَّحيحِ المستقيمِ فلا بُدَّ أن يكونَ مهتديًا أي على دينِ الله تبارك وتعالى وعلى تقواهُ.
وقولُه: "ناعمَ البالِ" أي مطمئنَّ البالِ للإيمانِ بالله تعالى وبما جاءَ عن رسولِهِ.
وقولُه: "ومن شاءَ أضل" أي أن الله تبارك وتعالى من شَاءَ في الأزلِ أن يكونَ ضالا أضلَّهُ، أي خَلَقَ فيه الضَّلالَ، وهذا الكلامُ من أصولِ العقائدِ التي كان عليها الصحابةُ ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ. فمن شاءَ الله له الهدايةَ لا بدَّ أن يهتديَ، الله يلهمُهُ الإيمان والتُّقى فيهتدي باختيارهِ لا مجبورًا، وأما من شَاءَ الله تعالى في الأزلِ أن يكونَ على خلافِ ذلكَ أي أن يكونَ ضالا كافرًا أضلَّهُ الله تبارك وتعالى أي جعلَهُ كافرًا، فيختارُ هذا العبدُ الكفرَ. فَلِمَا في هذهِ الأبياتِ من التّوحيدِ الخالصِ كان يُعجبُ بهنَّ عمر بن الخطَّابِ رضي الله عنه فلتُحفظ فإنهن من جواهرِ العلمِ في أصولِ العقيدةِ.
ولا التفاتَ إلى ما يقولُهُ بعضُ الناس: "الله ما خلقَ الشرَّ" فلتُحذَر وليُحَذَّر منها، فيجبُ تعليمُ الأطفالِ أن الله خالقُ الخيرِ والشَرّ ولكن يحبُّ الخيرَ ولا يحبُّ الشرَّ، والله لا يُسأَل عما يفعل.
قال المؤلف رحمه الله: وروى البيهقيُّ عن الشافعيّ أنّه قَالَ حينَ سُئِل عن القَدَرِ:
ما شِئتَ كانَ وإن لم أشأ ***** وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن
خَلقتَ العبادَ على ما علمتَ ***** ففي العلمِ يجري الفَتَى والمُسِن
على ذا منَنْتَ وهذا خذلْتَ ***** وهذا أَعنتَ وذا لم تُعِنْ
فمنهم شَقيٌّ ومنهم سَعيدٌ ***** وهذا قبيحٌ وهذا حَسَن
الشرح: هذه الأبياتُ رواهَا عن الشَّافعي الرّبيعُ بنُ سليمانَ رضي الله عنه وهو من رواةِ الإمامِ الشافعي رضي الله عنه، وقد فَسَّرَ الشافعيُّ القَدَرَ في هذه الأبيات بالمشيئةِ، وهو تفسيرٌ من الإمامِ الشافعي للقَدَرِ على وجهِ البَسطِ والتَّوسُّعِ، وحاصلُهُ أن الله تبارك وتعالى مُتَّصِفٌ بمشيئةٍ أزليةٍ أبديّةٍ لا تتغيّر كسائرِ صفاتِهِ، لا يطرأُ عليها الزّيادةُ والنُّقصانُ، وَجَعَلَ للعبادِ مشيئةً حادثةً تقبلُ التغيّرَ.
يقولُ الشافعيُّ رضي الله عنه مخاطبًا لله تبارك وتعالى: "ما شئتَ"، أي يا ربَّنا "كان" أي ما سبقت به مشيئتكَ في الأزلِ لا بدَّ أن يوجدَ "وإن لم أشأ" أي وإن لم أشأ أنا أي أنا العبدُ حصولَهُ، لأنَّ مشيئةَ الله نافذةٌ لا تتغيّرُ، والمعنَى أن مشيئةَ العبدِ تابعةٌ لمشيئةِ الله فهي مخلوقةٌ حادثةٌ، فكلُّ مشيئةٍ في العبادِ حَصَلت فإنما حَصَلت فينا لأن الله تعالى شاءَ في الأزلِ أن نشاءَ فتنفَّذَت مشيئةُ الله تعالى فينا أن نشاءَ، ثم مرادُنا الذي تَعَلَّقت به مشيئتُنَا لا يحصُلُ إلا أن يشاءَ الله حصولَ هذا المراد وتحقُّقَهُ.
فمشيئةُ الله نافذةٌ لا محالةَ لأنه لو كانَ لا يتحقَّقُ شىءٌ من مُرَادَاتِ الله تعالى أي مما شاءَ الله تعالى أن يتحقَّقَ ويحصلَ لكان ذلك عجزًا والعجزُ مستحيلٌ على الله، لأن من شأنِ الإلهِ أن تكونَ مشيئتُهُ نافذةً في كلّ المراداتِ، من خصائصِ الإله أن تكونَ مشيئتُهُ نافذةً لا تَتَخَلَّفُ، أي لا بدَّ أن يحصلَ ما شاءَ الله دخولَهُ في الوجود، فيجبُ عقلًا وشرعًا نفاذُ مشيئةِ الله تبارك وتعالى أي تحقُّقُ مقتضاها.
قالَ رضي الله عنه:" وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن" معناه إن أنا شئتُ حصولَ شىءٍ بمشيئتي الحادِثَةِ إن أنت يا ربّي لم تشأ حصولَهُ بمشيئتِكَ الأزلية لا يحصل، لأن مشيئةَ الله أزليّةٌ نافذةٌ لا تَتَخَلَّفُ وأما مشيئةُ العبدِ فحادثةٌ، منها ما هو نافذٌ ومنها ما هو غير نافذٍ أي منها ما يتحقَّقُ ومنها ما لا يتحقَّقُ.
ومعنى قوله رضي الله عنه: "خلقتَ العبادَ على ما علمتَ"، معناهُ أن الله تبارك وتعالى يبرزُ عبادَهُ من العدمِ إلى الوجودِ على حسبِ ما سَبَقَ في علمِهِ الأزليّ لا على خلافِ علمه الأزليّ، لأن تَخَلُّفَ العلمِ في حقّ الله تعالى مستحيلٌ يجبُ تنزيهُ الله عنه.
وقوله رضي الله عنه: "ففي العلمِ يجري الفتى والمُسنّ"، في هذا الكلام حكمةٌ كبيرةٌ، أي أن سَعيَ الفتى أي الشَّابّ والمُسنّ أي العجوز كلٌّ سعيُهُ في علمِ الله تبارك وتعالى أي لا يخرُجُ عن علمِ الله، هذا الفتى الذي هو ذو قوّةٍ ونشاطٍ، وهذا المُسنُّ الذي هو ذو عجزٍ وضعفٍ كلٌّ منهما لا يحصلُ شىءٌ منه من الحركاتِ والسَّكناتِ والنَّوايا والقصودِ والإدراكاتِ إلا على حَسَبِ علمِ الله الأزليّ، كلٌّ منهما في العلمِ يجريانِ أي يتقلَّبَانِ على حسبِ مشيئةِ الله الأزليّةِ، ويعملانِ على حسبِ علمِ الله الأزليّ ويتصرّفانِ ويسعيانِ على حسبِ علمِ الله الأزليّ.
قال رضي الله عنه: "على ذا مَنَنتَ وهذا خَذَلت" أي هذا مَنَنتَ عليهِ أي وَفَّقتَهُ للإيمانِ والهُدَى والصَّلاحِ وعُلوّ القدرِ في الإيمانِ، ومعنى توفيق الله لعبدِهِ أي يجعلهُ يصرفُ قدرتهُ واختيارهُ إلى الخيرِ، ومعنى: "وهذا خذلتَ"، أي وهذا ما وَفَّقتَهُ فلم يهتد للحقّ ولم يقبَل الحَقَّ، ومعنى خذلان الله لعبدِهِ أي يجعلهُ يصرفُ قدرتهُ واختيارهُ للشَّرّ.
قال رضي الله عنه: "وهذا أعنتَ وذا لم تُعِن"، أي هذا أعنتَهُ على الأعمالِ التي ترضيكَ، والآخرُ ما أعنتَهُ على ما يرضيكَ.
وليس معنى قول الشافعي: "وهذا أعنتَ وذا لم تُعِن" أن الله لا يعينُ على الشَّر وإنما يعينُ على الخيرِ فقط، فأهلُ السنة متفقونَ على أن الله هو المعينُ على الخيرِ وهو المعينُ على الشر، والإعانةُ التمكينُ أي أن الله هو الذي يُمَكّنُ العبدَ لفعلِ الخيرِ وهو الذي يمكّنهُ لفعلِ الشَّر، صرحَ بذلك إمامُ الحرمين وأبو سعيد المتولي قبلَهُ والشيخُ محمدُ الباقر النقشبنديّ والأميرُ الكبيرُ المالكيُّ صاحب المجموع وقد جَهِلَ هذا الاعتقادَ الحقَّ الضروريَّ بعضُ جهلةِ النقشبنديةِ في هذا العصرِ.
قال رضي الله عنه: "فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدٌ، وهذا قبيحٌ وهذا حَسَن". المعنى أن مَن شاءَ الله له أن يكونَ شقيًّا أي من أهلِ العذابِ الأليمِ كان كذلك، ومن شاءَ الله له أن يكونَ سعيدًا من أهلِ النّعيمِ المقيمِ كان كذلك.
وليُعلَم أن كتابَ الشَّقَاءِ والسَّعادةِ ثابتٌ لا يُغَيَّرُ ولا يدخلُهُ التَّعليقُ وإنما الذي يُغَيَّرُ ما كانَ من نحو الرّزقِ والمصيبةِ.
فالدّعاءُ ينفعُ في الأشياءِ التي هي مما سوى السّعادةِ والشقاوةِ، لأن السعادةَ والشقاوةَ هذا شىءٌ لا يدخلهُ التعليقُ لأن السعادةَ هي الموت على الإيمانِ والشقاوةَ هي الموت على الكفر، فمن عَلِمَ الله أنه يموتُ على الإيمانِ لا يتبدَّلُ ذلكَ، ومن عَلمهُ يموتُ على الكفر لا يتبدلُ ذلك. فكلا الفريقين يُختم له على ما كتب له ولو سبق له التنقل من إيمانٍ إلى كفرٍ أو من كفرٍ إلى إيمانٍ مرات عديدة.
أما السعادةُ الدّنيويّةُ تَتَبَدَّلُ وقد يدخلُهَا التَّعليقُ بأن يكونَ كُتِبَ في صحفِ الملائكةِ إن دَعَا بكذا أو تصدَّقَ بكذا أو وَصَلَ رَحِمَهُ أو برَّ والديهِ يَنَالُ كذا وإن لم يفعل ذلك لا ينالُ ذلكَ الشىء. السعادةُ الدنيويةُ هي كالبيتِ الواسِعِ والمركَبِ الهنيء والزوجةِ الصالحةِ والجارِ الصَّالحِ، هذه الأمورُ الأربعةُ هي من السّعادةِ الدنيويةِ كما جاءَ ذلكَ في الحديثِ الذي رواه الحافظ ضياءُ الدين المقدسيُّ.
قال المؤلف رحمه الله: فتبيّنَ بهذا أنَّ الضّميرَ في قولِه تعالى: ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ [سورة النحل/93] يعودُ إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القَدريّةُ بدليلِ قولِه تعالى إخبارًا عن سيّدنا موسى: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء﴾ [سورة الأعراف/155].
الشرح: موسى عليه السلام لما ذَهَبَ لميقاتِ ربّه أي لمناجاة الله أي لسماعِ كلامِ الله الأزلي خَلَّفَ على قومِهِ أخاهُ هارونَ وكان نبيًّا، ثم قَضَى أربعينَ ليلةً ثم عادَ إليهم فوجدَهم قد عبدوا العجل إلا بعضًا منهم وذلك بعد أن اجتازَ بهم البحرَ ورأوا هذه المعجزةَ الكبيرةَ وهي انفلاقُ البحرِ اثني عشر فرقًا كل فرقٍ كالجبلِ العظيم وأنقذَهُم من فرعونَ، فتنهم شخصٌ يُقالُ له موسى السَّامري فقد صاغَ لهم عجلًا من ذهبٍ ووضعَ فيه شيئًا من أَثَرِ حافرِ فرسِ جبريلَ، لأنه عندما أرادَ فرعون أن يَخوضَ البحرَ كانَ جبريلُ على فرسٍ، هذا الخبيث رأى موقفَ فرس جبريل فأخذَ منه شيئًا ووضعَهُ في هذا العجلِ المصوَّرِ من ذهبٍ فأحيا الله تعالى هذا العجلَ فصارَ يخورُ كالعجلِ الحقيقي خلقَ الله فيه الحياةَ، فقال لهم السّامريُّ: هذا إلهكم وإلهُ موسى، حملهم على عبادةِ هذا العجل فَفُتنوا فعبدوا هذا العجلَ، فلما أُخبِرَ سيدنا موسى بذلك اغتاظَ على هؤلاءِ اغتياظًا شديدًا، ثم أخذَ هذا السّامري فقالَ له سيدنا موسى: ﴿وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [سورة طه/97].
ثم اختارَ موسى وجرّدَ من قومِهِ سبعينَ شخصًا ليأخذَهم للتّضرّعِ إلى الله تعالى فأخذتهم الرَّجفةُ أي اهتزَّت بهم الأرضُ، فقال موسى متضرّعًا إلى الله: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ (155) ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ [سورة الأعراف/156].
معناهُ هذا الأمر الذي حَدَثَ بقومي من عبادتهم العجلَ فِتْنتُكَ أي امتحانٌ وابتلاءٌ منكَ، تُضلُّ بها من تشاءُ وتهدي من تشاءُ أي يا ربّي أضللتَ بها قِسمًا وهديتَ قسمًا. وقد ضلَّ عن معنى هذه الآية أناس يدّعون العلم فقالوا في قوله تعالى ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء﴾ [سورة المدثر/31] أي إن شاء العبد الضلالة يضله الله، لأنهم يعتقدون أن الله ما شاء ضلالة من ضل إنما هم شاءوا والله شاء لهم الهداية، فجعلوا مشيئة الله مغلوبة حيث إنها لم تتنفذ على قولهم ومشيئة العبد جعلوها نافذة فجعلوا الله مغلوبًا، والله غالب غير مغلوب. وعقيدتهم هذه تنقيص لله تعالى فليعلموا ذلك. ومن هؤلاء في هذا العصر فرقة نبغت في دمشق وهم جماعة أمين شيخو، كان لا يحسن العربية ولا علم الدين انتسب للطريقة النقشبندية على يد شيخ صالح ولم يسبق له تعلم علم العقيدة ولا الأحكام إنما كان شرطيًّا أيام الاحتلال الفرنسي فتبعه أناس جهال لم يتلقوا علم الدين وإن كان بعضهم تلقى العلوم العصرية فضلوا وأضلوا، منهم رجل يقال له عبد الهادي الباني ومنهم رجل منءال الخطيب عمل تفسيرًا فصار يفسر بعض ءايات المشيئة بهذا الاعتقاد الفاسد.
فائدةٌ: قال بعضُ العلماءِ: اليهودُ مشتقٌّ ومأخوذٌ من قولِ قوم موسى ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ (156) أي رجعنا إليكَ يا الله. وهذا لا ينطبق إلا على الذين كانوا مؤمنين به وبشريعته على ما هي عليه أما هؤلاء أخذوا الاسم وهم ليسوا على شريعة موسى وذلك منذ كفروا بعيسى وأما ابتداء تحريفهم للتوراة فيحتمل أن يكون قبل مجيء عيسى لكن زادوا في التحريف بعد مجيء عيسى عليه السلام.
قال المؤلف رحمه الله: وَكَذَلِكَ قَالَتْ طَائِفَةٌ ينْتَسِبُونَ إلى أمِين شَيخُو الذينَ زَعِيمُهُمُ اليَومَ عَبدُ الهادِي البَاني الذي هُوَ بدمَشْقَ فَقَدْ جَعَلُوا مَشِيْئَةَ الله تَابِعَةً لمشِيئَةِ العَبْدِ حَيْثُ إِنَّ مَعْنى الآيةِ عِنْدَهُم إنْ شَاءَ العَبْدُ الاهتداء شاء الله له الهدى وإنْ شَاءَ العَبْدُ أَنْ يَضِلَّ أضَلَّهُ الله، فكَذَّبوا بالآيَةِ: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ﴾ [سورة التكوير/29].
فَإنْ حَاوَلَ بَعْضُهُم أنْ يَسْتَدِلَّ بآيَةٍ منَ القُرءانِ لضِدّ هَذَا المَعْنَى قيلَ لَهُ: القُرءانُ يَتَصادَقُ ولا يَتَنَاقَضُ فَليْسَ في القرءانِ ءايةٌ نَقِيضَ ءايةٍ ولَيْسَ هَذَا مِنْ بَاب النَّاسِخ والمَنْسُوخِ، لأَنَّ النَّسْخَ لا يَدْخُلُ العَقائِدَ ولَيْسَ مُوجِبًا للتّنَاقُضِ فالنسخُ لا يدخلُ في الأخبارِ إنما هو في الأمرِ والنهي. إِنَّما النَّسْخُ بَيَانُ انْتِهاءِ حُكْمِ ءايةٍ سَابقَةٍ بحُكْمِ ءايَةٍ لاحِقَةٍ، عَلَى أَنَّ هَذِه الفِئَةَ لا تُؤمِنُ بالنَّاسِخِ والمَنْسُوخِ.
ومِنْ غَبَاوتِهِمُ العَجِيبَةِ أنَّهُم يُفَسّرُونَ قولَه تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءادَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا﴾ [سورة البقرة/31] بأسماء الله الحُسْنى، فَإنْ قِيلَ لَهُم: لَوْ كَانَت الأَسْماءُ هي أسْمَاءَ الله الحُسْنَى لَمْ يَقُل الله: ﴿فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ﴾ [سورة البقرة/33] بَلْ لَقَالَ فَلَمّا أَنْبأَهُم بأَسْمائِي انقَطَعُوا، لَكِنّهُم يُصِرُّونَ على جَهْلِهم وتَحْرِيفِهمْ للقُرءانِ.
الشرح: هؤلاءِ تَبِعوا المعتزلةَ في هذه المسألةِ فقاسوا الخالقَ على المخلوقِ فَضَلّوا وحَرَّفوا معنى الآية التي يحتجُّونَ بها وهي قوله تعالى: ﴿فَيُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ (4) ظنًّا منهم أننا إذا قلنا إن الله هو الذي يُضلُّ من شاءَ له الضَّلالةَ من عبادِهِ فقد نسبنا الظُّلمَ إلى الله، قالوا: كيفَ يشاءُ الله الضّلالةَ له ثم يعاقبهُ على ذلكَ، من هنا ضلُّوا فقالوا في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء﴾ (31) : يشاءُ أي العبدُ يعيدونَ الضَّميرَ إلى ﴿مَن﴾ (31) ، و﴿مَن﴾ (31) عندهم واقعٌ على العبدِ، فعندهم معنى الآية العبدُ الذي يشاءُ الضّلالَ يضلُّه الله، هكذا هم يحرّفون، لكنَّ الصَّوابَ إعادةُ الضَّميرِ إلى الله: ﴿يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء﴾ (31) أي العبدُ الذي شاءَ الله بمشيئتهِ الأزليَّة الأبديّةِ أن يَضِلَّ يُضِلُّهُ الله، هذا معنى الآية: ﴿يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاء﴾ (31) إلى لفظِ الجلالةِ يعودُ الضّميرُ.
ومعنى قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاء﴾ (4) أي أن الله تبارك وتعالى هو إن شاءَ بمشيئتهِ الأزليَّةِ الأبديَّةِ أن يهتديَ شخصٌ يهتدي ذلك الشَّخصُ، ينساقُ باختيارِهِ إلى الهُدَى، فيختَارُ الهُدَى والإيمان لأن الله شاءَ له ذلك. وهذا هو الموافِقُ لآياتٍ أخرى كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ﴾ [سورة الروم/29]، وقوله: ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [سورة غافر/33] وأصرحُ ءايةٍ في إبطالِ عقيدةِ هذه الهادوية الشيخوية وهم المنتسبونَ إلى عبد الهادي الذي هو تلميذ أمين شيخو الآية وهي ﴿تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء﴾ [سورة الأعراف/155] لأن قوله تعالى ﴿تَشَاء﴾ ﴿155﴾ صريحٌ في نسبةِ المشيئةِ إلى الله، فلو كانَ معنى الآية كما زعموا لكانَ لفظُ الآيةِ يَضِلُّ بها من شاءوا أي الذين عبدوا العجل لكن موسى يخاطب الله بقوله ﴿مَن تَشَاء﴾ (155) فلا معنى للآية إلا تضل بها من تشاء أنت يا الله، فَلتَعلم هذه الفرقةُ أنها ضدُّ القرءانِ وأنها خارجةٌ عن الإسلامِ.
ومن كفرهم قولُهم إن الله لا يعذّبُ والتعذيبُ صفةُ نقصٍ فكذَّبوا قولَهُ تعالى: ﴿يُعَذِّبُُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء﴾ [سورة العنكبوت21]، ويحرفونَ قولَه تعالى: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [سورة البقرة/196] يقولونَ: العقابُ هو التعقُّبُ ليس التعذيب، ويقولون قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءادَمَ الأَسْمَاء﴾ [سورة البقرة/31] أي الأسماء الحُسنى فيخالفونَ حديثَ رسولِ الله المتفق على صحتِهِ الذي فيه أن الناسَ يقولونَ لآدمَ يوم القيامَةِ: "يا ءادم أنت أبو البشر أسجد لك الملائكة وعَلَّمَكَ أسمَاء كلّ شىءٍ".
تنبيه: الجادَّةُ عند علماءِ النَّحوِ أن الضَّميرَ يُعَادُ إلى أقربِ مذكورٍ إذا لم يكن هناكَ دليلٌ على عودِهِ إلى ما قبلَهُ أي إلى ما قبلَ الأقربِ، وأما إذا كان يوجدُ دليلٌ على إعادةِ الضَّميرِ إلى ما قبلَ هذا الأقرب أُعيدَ الضَّميرُ إلى ما قبلَ الأقربِ، هذهِ القاعدةُ عندهم. وهنا الدَّليلُ يَمنَعُ من إعادةِ ضميرِ ﴿يَشَاء﴾ (21) إلى ﴿مَن﴾ (21) الذي هوَ العبدُ، وهذه الفرقةُ مخالفةٌ لهذه القاعدةِ بل لا يجعلونَ للعربيةِ اعتبارًا إلا خواطرهم التي هي عندهم فيضٌ من قلبِ رسولِ الله إلى قلبِ أبي بكرٍ إلى قلوبِ شيوخِ النقشبنديةِ إلى أن تصل إلى قلبِ شيخهم.
فإن قيلَ: هذه الآيةُ نُسِخَت بآيةٍ أخرى، قلنا: النَّسخُ لا يدخُلُ العقائد ولا يؤدّي إلى التَّناقض، واعتقادُ أن مشيئةَ العبدِ تابعةٌ لمشيئةِ الله وليسَ العكس من أصولِ الاعتقادِ، ومن خالَفَ في ذلك فقد كَفَرَ والعياذُ بالله.
قال المؤلف رحمه الله: ورَوَى الحَاكِمُ رحمَهُ الله تَعالى أنَّ عَليَّ الرّضَى بنَ مُوْسَى الكَاظِمِ كانَ يَقْعُدُ في الرَّوْضَةِ وهُوَ شَابٌّ مُلْتَحِفٌ بمَطْرَفِ خَزّ فَيَسْأَلُهُ النَّاسُ ومَشَايخُ العُلَمَاءِ في المَسْجِدِ، فسُئِلَ عن القَدَرِ فقَالَ: قالَ الله عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) [سورة القمر] ثُمَّ قَالَ الرّضَى: كَانَ أَبي يَذْكُر عَن ءابَائِهِ أَنَّ أَمِيْرَ المُؤمِنيْنَ عَليَّ بنَ أبِي طالبٍ كانَ يَقُولُ: "إنَّ الله خَلقَ كُلَّ شَىءٍ بقَدَرٍ حَتَّى العَجْزَ والكَيْسَ وإلَيْهِ المشِيئَةُ وبِه الحَوْلُ والقُوّةُ" اهـ.
الشرح: الحاكمُ رحمه الله تعالى هو شيخ البيهقيّ رحمَهُ الله وقد رَوَى هذا الكلامَ العظيمَ الذي يحوي معاني راقيةً كثيرةً، فقوله: "إن الله خلقَ كلَّ شىءٍ بقدرٍ" أي بتقديرهِ الأزليّ أي أن كلَّ ما دَخَلَ في الوجودِ فقد وُجِدَ بتقديرِ الله وجودَه ومشيئتِهِ لوجوده، وقوله: "حتى العجزَ والكيس"، فالعجزُ هو الضّعفُ في الفهمِ والإدراكِ ويقال العجزُ هو ضعفُ الهمَّةِ وفُتورُها، أما الكيسُ فهو الذَّكاءُ والفطانَةُ، وأما قوله: "وإليه المشيئة"، فمعناهُ أن الله تبارك وتعالى له المشيئةُ الشّاملةُ العامّةُ الأزليّةُ الأبديّةُ التي لا تتحوّلُ ولا تتغيّرُ، فبمشيئتهِ الأزليّةِ شاءَ حصولَ كلّ الممكناتِ الحادثاتِ من أجرامٍ وأعمالِ العبادِ حركاتِهِم وسكناتِهِم وتطوّراتِ نفوسِهم واعتقاداتهم ما كان خيرًا وما كان شرًّا، ومشيئةُ الله سابقةٌ على مشيئةِ العبادِ، سبقت مشيئتُهُ المشيئاتِ كُلّها لا مَشيئةَ للعبادِ إلا ما شاءَ لهم.
فما يقولُهُ بعضُ الناس: إن لله عبادًا إذا أرادوا أرادَ، فهذا اللّفظُ غيرُ مستحسنٍ وتركُهُ خيرٌ لأنه يُوهِمُ أن الله تبارك وتعالى يُحدِثُ مشيئةً، ومشيئةُ الله أزليّةٌ ليست مما يَحدُثُ كهذهِ الحادثَاتِ، نقولُ كما جاءَ في الحديثِ: "إن لله عبادًا لو أقسموا على الله لأَبَرَّهم" أخرجَ ما في معناه البخاريُّ وغيرُه، أي يعطيهم ويُحققُ مرادهم كما جاءَ في الحديث: "رُبَّ أشعثَ أغبرَ ذي طمرين مدفوعٍ بالأبوابِ لو أقسمَ على الله لأَبَرَّهُ" أخرجَهُ مسلمٌ وغيرُه، ومعناهُ كثيرٌ من المؤمنينَ أشعث أي لا يتمكّنُ من خدمَةِ جسدِهِ، من شدّةِ البؤسِ والفقرِ يتركُ شعرهُ منتفشًا أشعث لا يسرّحهُ لا يتمكّنُ من تسريحِهِ على حسبِ العادةِ مع قلة الماء في أراضيهم وليس من عدم عنايتهم بالنظافة إنما يعجزون مع شدة البؤس والفقر فيصير أحدهم أشعث أغبر، وقولُه: "أغبر" أي ثيابه لا يستطيعُ أن يتعهَّدَهَا بالغسلِ والتّنظيفِ من شدّةِ البؤسِ والفقرِ بل تعلوها الغبرةُ، وقولُه: "ذي طمرين" - أي يلبسُ طمرينِ أي ثوبَينِ ثوبًا للنّصفِ الأعلى وثوبًا للنّصفِ الأسفلِ، وقولُه: "مدفوعٍ بالأبواب"، معناهُ النّاسُ لا يقدّرونهُ يدفع بالأبوابِ، إذا جاءَ لحاجةٍ إلى بابِ إنسانٍ يُدفَعُ من رثاثةِ ثيابهِ وهيئتهِ ولا يمكَّنُ من الدّخولِ لأن شعرهُ أشعث وثيابهُ مغبرة، هذا العبدُ له عندَ الله منزلةٌ عاليةٌ بحيثُ لو أقسمَ على الله لأَبَرَّهُ أي لو قالَ يا ربّ أُقسِمُ عليكَ أن تفعل بي كذا أو أن تفعلَ بفلانٍ كذا ينفّذُ له إقسامهُ أي يعطيه مرادهُ، لكنَّ هؤلاء قلوبُهم متعلّقةٌ بالآخرةِ، قلَّ أن يَطلبوا أمرًا دنيويًّا يتعلّقُ بالمعيشةِ، فهؤلاء لو أقسموا على الله فهو لمصلحةٍ دينيّةٍ لا لشهواتِ أنفسِهِم.
وأمّا قولُ سيّدنا عليّ: "وبه الحول والقوّة"، فالحولُ هو التَّحفُّظُ عن الشَّرّ، والقوَّةُ هي القوّةُ على فعلِ الخيرِ التي تحصُلُ في العبادِ، معناهُ أنّ العبدَ لا يستطيعُ أن يدفَعَ عن نفسهِ شرًّا، ولا يستطيعُ أن يحترزَ عن سوءٍ وشرّ وفسادٍ ومعصيةٍ إلا بالله أي إلا بعونِ الله، أي إلا أن يحفظَهُ الله، فالملائكةُ والأنبياءُ والصّالحونَ من المؤمنينَ ليسوا هم يحفظون أنفسَهم من الضَّلالِ مستقلّينَ عن الله تعالى بل الله هو يحفظُهم، فللّه المِنَّةُ عليهم، الفضلُ لله الذي حفظهم ولولا حفظُ الله لهم ما سَلِموا من هذه المعاصي والرَّذائلِ. وقوله: "والقوّةُ" معناهُ أنّه لا أحد يقوَى على طاعةٍ وحسنةٍ وعملٍ شريفٍ إلا بتقديرِ الله ومشيئتِهِ وعلمِهِ وتوفيقِهِ، فالذين وفَّقهم الله لفعلِ الطَّاعاتِ فعمِلوها وحقَّقوها فليسَ ذلك إلا بعونِ الله، فلولا معونةُ الله ما عملوا حسنةً فللّه الفضلُ والنّعمة، هذا من خالصِ التّوحيدِ وجواهرِ العلمِ، هذه عبارةٌ مُوجَزَةٌ لكنْ مُفادها واسع.
قال المؤلّف رحمه الله: فَالعِبَادُ مُنْسَاقُونَ إلى فِعْلِ ما يَصْدُرُ عَنْهُم باختِيَارِهم لا بالإكْراهِ والجَبْرِ كالريشةِ المعلقةِ تُمِيلُها الرياحُ يمنةً ويسرةً كما تقولُ الجبريةُ.
الشرح: الخلقُ منساقونَ إلى ما شاءَ الله تعالى في الأزلِ وعَلِمَ أنّهم يفعلون، لا بدَّ أن ينساقوا إليه باختيارِهم، المؤمنونَ الذين ءامنوا ينساقونَ إلى الإيمانِ باختيارِهم والكفّارُ الذين شاءَ الله تعالى أن يموتوا كافرينَ انساقوا إلى الكفرِ باختيارِهم، تَنفَّذت مشيئةُ الله في هؤلاءِ وهؤلاءِ.
قال المؤلّف رحمه الله: ولَوْ لَمْ يَشَأ الله عِصْيَانَ العُصَاةِ وكُفْرَ الكَافِرِيْنَ وإيمانَ المؤمنينَ وطَاعَةَ الطّائِعيْنَ لَمَا خَلَقَ الجنَّةَ والنّارَ.
ومَنْ يَنْسُبُ لله تَعالى خَلْقَ الخَيْرِ دُوْنَ الشَّرّ فَقَدْ نَسَبَ إلى الله تعالى العَجْزَ ولَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ للعَالَمِ مُدَبّرانِ، مُدَبّرُ خَيْرٍ ومُدَبّرُ شرّ وهَذا كفرٌ وإشْراكٌ.
الشرح: لا يجوزُ أن يكونَ للعبدِ إرادةٌ تتنفَّذُ بخلافِ إرادةِ الله كما تقولُ المعتزلةُ، هؤلاءِ يقولونَ الله شاءَ لكلّ العبادِ حتّى لفرعونَ أن يكونَ مؤمنًا تقيًّا وكذلك لإبليسَ ولكن نَقَضا مشيئة الله، يقولونَ هما اختارا الكفرَ فكفرا فلم تتنفَّذ فيهما مشيئةُ الله، جعلوا الله مغلوبًا والله تعالى غالبٌ غير مغلوبٍ، فإذن هم وَصَفوا الله بالعجزِ والمغلوبيّةِ، والألوهيّةُ تنافي المغلوبيّةَ.
قال المؤلّف رحمه الله: وهَذَا الرَّأْيُ السَّفيهُ من جِهَةٍ أخْرَى يَجْعَلُ الله تَعالى في مُلْكِه مَغْلُوبًا، لأنّهُ على حَسَبِ اعتِقَادِه الله تَعَالى أرَادَ الخَيْرَ فَقَط فَيكُونُ قَدْ وقَعَ الشّرُّ مِنْ عَدُوّه إبْليسَ وأعْوانِه الكُفَّارِ رَغْم إرادته.
ويَكْفُرُ مَنْ يَعْتَقِدُ هَذَا الرَّأْيَ لمخَالفَتِهِ قَولَه تَعالى: ﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [سورة يوسف/21] أيْ لا أحَدَ يَمْنَعُ نَفَاذَ مَشِيْئَتِهِ.
الشرح: الله تعالى شاءَ كلّ ما يدخُلُ في الوجودِ، كلُّ ما يعملهُ العِبادُ باختِيارِهم وبغيرِ اختِيارهم فهو بمشِيئةِ الله تعالى يكونُ، فلو كانَ الله شاءَ لهؤلاءِ الكفَّارِ أن يهتدوا ما بقِي مِنهم أحدٌ إلا اهتدَى لكنَّه لم يشأ لهؤلاءِ الكفَّارِ أن يهتدوا، هو أمرَهم بالإيمانِ ولكِن لم يشأ لهم الإيمانَ، ما شاءَ الله كانَ وما لم يشأ لم يكن.
الله تعالى شاءَ للمؤمنينَ أن يكونوا مؤمِنينَ باختِيارِهم فآمنوا، وشاءَ للكافرينَ أن يكفروا باختِيارهم فكفروا، ولو كانَ شاءَ لهم الإيمانَ لآمنوا، هذا اعتقادُ أهلِ الحقّ. فما شاءَ الله وجودهُ لا بدّ أن يوجَدَ، لا أحد يمنعُ نفاذَ مشِيئةِ ﴿الله وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ (21) معناه يُنفّذُ مرادَهُ، ما شاءَهُ لا بدَّ أن يُنفَّذَ، والله غالبٌ على أمرِهِ أي مُنَفّذٌ لمُرَادِهِ لا محالَة.
قال المؤلف رحمه الله: وحُكْمُ مَنْ يَنْسُبُ إلى الله تعَالى الخَيرَ ويَنْسُبُ إلى العَبْدِ الشّرَّ أدَبًا أنَّه لا حَرَجَ عليه، أمَّا إذَا اعْتَقدَ أنَّ الله خَلَقَ الخَيْر دُوْنَ الشَّرّ فَحكمُهُ التَّكفِيرُ.
الشرح: إذا قال قائل نَنسبُ الخيرَ إلى الله وننسبُ الشرَّ إلى أنفسِنا أو إلى الشَّيطانِ أو إلى الكفَّارِ تأدُّبًا مع الله كأن قال: "الخيرُ من الله والشَّرُّ ليسَ إليهِ" فلا حَرَجَ عليهِ ولا بأسَ بذلك، لأنَّ هذا ليسَ معناهُ أنَّ الله ما شاءَ وقوعَ الشَّر، إنّما معناهُ الشرُّ لا يُتَقَرَّبُ بهِ إلى الله والخيرُ يُتَقَرَّبُ بهِ إلى الله.
أمّا الذي يعتقدُ أنّ الله خَلَقَ الخيرَ ولم يَخْلق الشَّرَّ وأنَّ الشَّرَّ من خَلقِ إبليس فهذا كافرٌ.
نقول الخيرُ منكَ، أمّا الشَّرُّ منكَ فهو إساءةُ أدبٍ. أما قولُ القائلِ: الخيرُ والشرُّ بمشيئةِ الله فلا ينافي الأدبَ مع الله، وذلك كقولِ القائلِ: الله خالق الإنسانِ والملائكةِ والبهائم والخنازير والقردة وكلّ المخلوقاتِ فإن هذا لا ينافي الأدبَ، وأما لو أَفردَ الخنازيرَ والقردةَ فقال: الله خالقُ الخنازير والقردة يكونُ إساءةَ أدبٍ.
قال المؤلّفُ رحمه الله: واعْلَمُوا رَحِمَكُمُ الله أنَّ الله تَعَالى إِذَا عَذَّبَ العَاصِيَ فَبِعَدْلِه مِنْ غَيْرِ ظُلْم، وَإِذَا أثَابَ المُطِيعَ فَبفَضْلِه مِنْ غَيرِ وجُوبٍ عليه، لأَن الظُّلْمَ إنَّما يُتَصَوَّرُ مِمَّن لهُ ءامِرٌ ونَاهٍ ولا ءامِرَ لله ولا نَاهيَ لَهُ، فَهُوَ يَتَصَرَّفُ في مُلْكِه كَما يَشَاءُ لأَنَّهُ خالِقُ الأشياءِ ومَالِكُها، وَقَدْ جَاءَ في الحَديثِ الصَّحِيح الذي رَوَاهُ الإمَامُ أحْمَدُ في مُسْنَدِه والإمَامُ أبُو دَاودَ في سُنَنِه وابن حبان عَن ابنِ الدَّيْلَميّ قَالَ: "أَتيْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: يَا أبَا المنْذِرِ، إنَّهُ حَدَثَ في نَفْسِي شَىءٌ مِنْ هَذا القَدَرِ فَحدّثْني لَعَلَّ الله يَنْفَعُني"، قَالَ: "إنَّ الله لَوْ عَذَّبَ أهْلَ أرْضِهِ وسَمهبهواتِه لعَذَّبَهُم وهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُم وَلَوْ رَحِمَهُم كَانَت رَحْمَتُه خَيْرًا لَهُم مِنْ أعْمَالِهم، ولَو أنفَقْتَ مِثلَ أحُدٍ ذَهَبًا في سَبِيْل الله مَا قَبِلَهُ الله مِنْكَ حَتَّى تُؤمِنَ بالقَدَرِ، وتَعْلَمَ أنَّ مَا أصَابَكَ لم يَكُن لِيُخْطِئَكَ ومَا أخْطأَكَ لم يكنْ ليُصِيبَكَ ولو مِتّ علَى غَيْرِ هَذا دَخَلْتَ النَّارَ". قَالَ: ثُمَّ أَتَيتُ عَبدَ الله بنَ مَسْعُودٍ فَحدَّثَني مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَيْتُ حُذَيفَةَ بنَ اليَمانِ فحدّثَني مِثلَ ذلكَ، ثمَّ أتَيْتُ زَيْدَ بنَ ثابتٍ فحدّثني مثلَ ذلكَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
الشرح: ذكرَ ابنُ الدَّيلميِّ أنهُ جاءَ إلى أبيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه صاحبِ رسول الله ويُكنى أبا المنذرِ فقال له: يا أبا المنذر إنّهُ حَدَثَ في نفسي شىءٌ من هذا القَدَرِ فَحدّثني لعلَّ الله ينفعني أي بكلامِكَ فقال له أبيّ: إنَّ الله لو عذَّب أهلَ أرضِهِ وسمواتِهِ لعذّبهم وهو غيرُ ظالمٍ لهم، أي لو عذَّبَ الملائكةَ والإنسَ والجنَّ لعذَّبهم ولا يكونُ ظالمًا، وإن رَحِمَهم من العذابِ كانت رحمتُهُ إحسانًا منه وتفضُّلًا وتكرُّمًا عليهم ولم تكن رحمتُه فرضًا واجبًا عليه وذلك لأنّه هو الذي يخلُقُ الطَّاعةَ في عبادِهِ، الملائكةُ والأنبياءُ وغيرُهم هو خَلَقَ فيهم هذه الطَّاعَةَ.
ثمَّ قال له: ولو كانَ عندكَ مثلَ أحدٍ من الذَّهَبِ فتصدَّقتَ به فأنفقتَهُ في سبيلِ الله أي فيما يحبُّه الله عبّأتَ الجيوشَ للجهادِ في سبيلِ الله وأمدَدتَّهم بالمالِ لم يقبلهُ الله منكَ حتّى تؤمِنَ بالقَدَرِ، وأحدٌ جبلٌ عظيمٌ بالمدينةِ، ثمّ قال له: وتَعلَمَ أنّ ما أصابَكَ لم يكن ليخطئَكَ وما أخطأَكَ لم يكن ليصيبَكَ ولو متَّ على غير هذا دخلتَ النّارَ، أي لو متَّ على غيرِ هذا الاعتقادِ لكنتَ من أهلِ النَّارِ من الكفَّارِ.
قال المؤلّف رحمه الله: وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحيحِهِ والبَيْهقيُّ في كِتَابِ القَدَرِ عنْ أبي الأسْوَد الدُّؤليّ قال: قالَ لي عِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ: أَرأَيْتَ ما يَعْمَلُ النَّاسُ اليَومَ ويَكْدَحُونَ فِيهِ أشَىءٌ قُضِيَ علَيهِم ومَضَى علَيهِم مِنْ قَدَرٍ قدْ سَبَقَ أوْ فِيمَا يُسْتَقبَلُونَ بهِ مِمَّا أتَاهُم به نَبيُّهُم وثَبَتَتِ الحُجَّةُ علَيْهِم؟ فقُلتُ: بَلْ شَىءٌ قُضِيَ عَليهم ومضَى عَلَيْهِم، قَالَ فَقَالَ: أفَلا يَكُونُ ظُلْمًا، قَالَ: فَفَزعْتُ مِنْ ذلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا وقُلْتُ: كُلُّ شَىءٍ خَلْقُهُ وَمِلْكُ يَدِهِ لا يُسْئَل عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْأَلُونَ، قال: فَقَالَ لي: يَرْحَمُكَ الله إِنّي لَمْ أرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلاَّ لأَحْزِرَ عَقْلَكَ، إنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيا رَسُولَ الله فقَالا: يا رَسُولَ الله أرَأيتَ ما يَعْمَلُ النّاسُ اليومَ ويَكْدَحُونَ فِيه أشَىءٌ قُضِيَ عَلَيهم ومَضَى عَلَيهم مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبقَ أَوْ فِيمَا يُستَقْبَلُون بِه ممّا أتَاهم بهِ نبِيُّهُم وثبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيهم؟ فَقَالَ: بَلْ شَىءٌ قُضِيَ علَيهِم ومضَى عَليْهِم، ومِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُ الله تَبَارَكَ وتَعَالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (7) ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (8) [سورة الشمس].
الشرح: هذا الحديثُ رواهُ البيهقيُّ في كتابِ القَدَرِ من حديث يحيى ابن يَعمر الذي هو أوَّلُ من نَقَطَ المصاحِفَ، عن أبي الأسود الدُّؤليّ الذي هو معروف بأنَّه من ثقاتِ التَّابعينَ أَخَذَ الحديثَ عن سيّدنا عليّ وغيرِهِ، وكان هو أوّل واضعٍ للنَّحوِ بإشارةِ سيّدنا عليّ، عن عمران بن الحصين الذي هو أحدُ فقهاءِ الصّحابةِ المجتهدينَ المشهورين بالعلمِ حتَّى قيل إنّه لم يدخل البصرةَ أفقه منهُ، أي أنَّ كلَّ من دَخَلَ البصرةَ من أصحابِ الرّسولِ فعمران أفقَهُهُم. وعمرانُ بن الحصين هو أيضًا من أولياءِ الصّحابةِ، الملائكةُ كانوا يزورونَهُ ثمَّ ذاتَ مرّةٍ استعملَ الكيَّ من أجلِ البواسيرِ، والتّداوي بالكيّ مكروهٌ لم يكن يحبّهُ رسولُ الله، فانقطعت عنهُ الملائكةُ ثمّ بعدَ بُرهةٍ عادوا لزيارتِهِ.
ومعنى قوله: "أرأيتَ ما يعملُ الناسُ اليومَ ويَكدحون فيه" أي يسعونَ إليه أي أعمالهم حركاتهم وسكناتهم، وقولُهُ: "أشىءٌ قُضِيَ عليهم ومضى عليهم من قَدرٍ قد سَبَق"، معناهُ هل هوَ شىءٌ قَدَّرَهُ الله تعالى أنّه سيحصلُ منهم أي باختيارِهم ومشيئتِهم الحادثةِ بعد مشيئةِ الله الأزليّةِ وعلمِهِ الأزليّ الأبدي، وقولُهُ: "أو فيما يُستقبلونَ بهِ"، معناهُ أم هوَ شىءٌ جديدٌ لم يسبق به قدرٌ ولم يسبق في علم الله في الأزلِ أنّه يحصلُ منهم إنّما هم من تلقاءِ أنفسِهم من غيرِ أن يكونَ لله تصرّفٌ فيه يعملونَ، أو هَل هم ليس لهم اختيارٌ بل هم مسلوبو الاختيارِ بالمرّةِ.
ومعنى قوله: "ممَّا أتاهم به نَبيُّهُم وَثَبَتَت الحُجَّةُ عليهم"، أي أريدُ منكَ نصًّا شرعيًّا.
ومعنى قوله: "بل شىءٌ قُضِيَ عليهم ومضَى عليهم"، أي أنّ حركات العبادِ وسكناتِهم كلَّها شىءٌ حصل من العبادِ بقضاء الله، ومعنى قوله: "أفلا يكونُ ظُلمًا"، أي أنّه أرادَ أن يزيدَ في امتحانِهِ فقالَ: أفلا يكون ظلمًا، والمعنى إن كانَ الإنسانُ يعمَلُ فيما قَدَّرَ الله تعالى، يعملُ على حسب مشيئةِ الله وعلمِهِ ثمَّ حاسبَهُ في الآخرةِ على هذا العمل فعاقَبَهُ ألا يكون ظلمًا، قال: "ففزعتُ من ذلكَ فزعًا شديدًا وقلت: كلُّ شىءٍ خلقُهُ وملكُ يدهِ لا يُسأَلُ عمّا يَفعَلُ وهم يسألونَ. ألهَمَ الله تعالى أبا الأسودِ الصَّوَابَ فأجابَ بما معناهُ أنَّ الله لا يَحكُمُهُ أحدٌ هو فعّالٌ لما يريدُ، جعلَ الأعمالَ أماراتٍ أي علاماتٍ، ووفّق بعضَ النّاسِ بأن يختاروا الهُدَى والصّالحات من الأعمالِ وينسَاقوا إليها باختيارهم على حسبِ مشيئتِهِ وعلمِهِ فيكونوا من أهل النّعيمِ المقيمِ، وأن ينساقَ قسمٌ منهم باختيارهم إلى ما نَهَى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقديرِ الله وعلمِهِ، فإذا حاسبَ العصاةَ وعاقَبَهم لا يكونُ ظالمًا لأنّه هو الحاكمُ ليسَ له حاكمٌ، هو الآمرُ ليسَ له ءامرٌ، تَصَرَّفَ فيما له فيما يملكهُ مِلكًا حقيقيًّا ولم يتصرّف فيما ليس له، لأن الظُّلمَ في لغةِ العرب هو أن يتصرّف بما ليسَ لهُ، والله تعالى كلّ شىءٍ خلقُهُ وملكُهُ، لا يسألُ عمَّا يفعلُ وهم أي العبادُ يسألونَ.
وقول عمران: "يرحمكَ الله إنّي لم أُرِد بما سألتُكَ إلا لأحزِرَ عقلَكَ"، معناه أنّه لمَّا وُفّقَ للجوابِ الصّحيحِ دَعَا له وَصَوَّبَ جوابَهُ وقال له: لم أُرِد بما سألتُكَ إلا لأحزِرَ عقلكَ أي أردتُ أن أمتَحِنَ فَهمَك للدّينِ.
ثمَّ قال عمران: "إنَّ رجلين من مُزينَةَ" وهي قبيلةٌ من قبائلِ العربِ "أتيا رسولَ الله فقالا: يا رسول الله أرأيتَ ما يعملُ النّاسُ اليومَ ويكدحونَ فيهِ أشىءٌ قُضِيَ عليهم ومضَى عليهم من قَدَرٍ قد سَبَقَ أو فيما يُستقبلون بهِ ممَّا أتاهم به نبيُّهم وثَبتَت الحُجَّةُ عليهم"، معناهُ نريدُ منك دليلًا وحجةً من الشرع، فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "بل شىء قُضِيَ عليهم ومَضَى عليهم" ومصداقُ ذلك قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (7) ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (8) [سورة الشمس]، المعنى أنَّ كلَّ ما يعملُ العبادُ من حركاتٍ وسكنات حتَّى النّوايا والقصود تكون على حسبِ مشيئةِ الله الأزليّةِ وعلمِهِ وتقديرِه، ثمَّ جزاهم على الحسناتِ الثوابَ وعلى السيئات العقابَ، والرّسولُ استدل بالآيةِ المذكورةِ وأيَّدَ جوابَهُ لهما لأنَّ الله أقسمَ بالنَّفسِ وما سوَّاها على أنَّ الله تبارك وتعالى هو الذي يُلهِمُ النّفوسَ فُجورَها وتقواهَا، أي أنَّه لا يكونُ شىءٌ من أعمالِ العبادِ خيرِها وشرّها إلا بخلقِ الله تعالى فيهم ذلك.
فيُعلَمُ من ذلك أنَّ أعمالَ العبادِ كلَّها خلقٌ لله تعالى وكسبٌ للعبادِ، أي نحن نُوَجّهُ إليها القصدَ والإرادةَ والقدرةَ التي هي حادثةٌ، وأمّا حصولُ ذلك الشَّىءِ ووجوده فهو بخلقِ الله، قالَ الله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [سورة البقرة/286] المعنَى أنَّ العبادَ يُثَابونَ على كَسبِهِم للحسناتِ ويعاقبونَ على كسبِهم للسَّيّئاتِ. فإثابة الطائعين فضل من الله وعقاب العاصين عدل منه.
فإن قالَ قائلٌ: إذا كانَ الله شاءَ لنا أن نفعلَ كذا من الكفرِ والمعاصي فماذا نفعلُ؟ فالجوابُ أن يُقالَ: المستقبلُ غَيبٌ عنَّا، ما بعدَ هذه اللَّحظة غيبٌ عنّا، فالذي علينا أن نَسعَى لأن نكونَ قائمينَ بحقوقِ الله تعالى وحقوقِ عبادِهِ التي أمرنا بها، ونعتقد في الوقتِ نفسِهِ أنه إن كانَ الله عَلِمَ وشاءَ أنّنا نسعى للخيراتِ كانَ ذلك علامةً على أنّنا من الذين شاءَ الله لهم أن يكونوا من أهلِ النّعيمِ المقيمِ في الآخرةِ، وإن لم يَتَيَسَّر لنا ذلكَ فلا نكون من أولئكَ فلا نستحقُّ ذلكَ بل نخشَى أن نكونَ من الذين أرادَ الله بهم أن يكونوا من أهلِ العذابِ المقيمِ، كما أنَّ الإنسانَ يبذرُ البذرَ وهو لا يعلمُ علمَ يقينٍ أنّه يدركُ محصولَ هذا الزّرعِ فإمَّا أن يموتَ قبلَهُ وإمَّا أن تحدُثَ ءافةٌ وعاهةٌ لهذا البذرِ فَتتلفَهُ وتُفسِدَهُ فلا يدرك الانتفاع بهذا الزّرعِ، إنّما نشرعُ فيه على الأملِ أي على احتمالِ أنّنا نعيشُ حتّى ينبتَ هذا البذر وندركهُ فيصيرَ حبًّا قوتًا أو ثمارًا ينتفعُ بها، كذلكَ أحدُنا إذا أصيبَ بمرضٍ يتداوَى على الأملِ لا يقطعُ بأنّه يتعافَى بهذا الدّواءِ بل يقولُ يحتملُ أن أتعافى بهذا الدّواءِ ويحتمل أن لا أتعافَى بهِ، وهذه أمورُ الآخرةِ كذلكَ. العواقبُ عنّا مستورةٌ محجوبةٌ إنّما نعلمُ ما حَصَلَ قبلَ هذا فنقولُ هذا حَصَلَ بمشيئةِ الله أمّا ما لم يقع بعدُ فإنّه غيبٌ عنّا، وكما لا يجوزُ للإنسانِ أن يقعدَ ويقولَ ما قَدَّرَ الله تعالى لا بدَّ أن يصلَ إلى جوفي ولا يسعَى بوجهٍ من الوجوهِ في طلب القوت بل يعرّضُ نفسَهُ للتّلفِ بالجوعِ، كذلك لا يجوزُ أن يقولَ الإنسانُ أنا إن كانَ الله كَتبَ أنّي سعيدٌ لا بدَّ أن أكونَ سعيدًا وإن كان كتبَ لي غير ذلك لا أكون سعيدًا ثمّ يقعدُ من غير أن يسعى لأن يكونَ من أهلِ النّجاةِ.
ثمّ يقالُ: فعلُ الله لا يقاسُ على فعلِ المخلوقِ، أمامنا أمرٌ يوافِقُ عليه المؤمنُ والمُلحِدُ وذلك الانتفاعُ بهذه البهائم، هذه البهائمُ خلقٌ كما أنّنا خلقٌ، هي تحسُّ باللَّذَّةِ والألمِ كما أنّنا نحسُّ باللَّذَّةِ والألمِ، فهل يعترض أحدٌ مِنَّا على ذبحِ هذه الذّبائح للانتفاعِ بها، هل هو محلُّ اعتراضٍ؟ هل يقولُ أحدٌ مِنَّا أو منهم: هذه البهائمُ لها أرواحٌ كما أنَّ لنا أرواحًا وتحِسُّ بألمٍ كما أنّنا نحسُّ بألمٍ فإذًا لا يجوزُ لنا أن نقضيَ عليها للوصولِ إلى لذَّاتِنَا، فيقالُ لهم: كما أنه لا اعتراضَ لكم في هذهِ ليسَ لكم اعتراضٌ على أنَّ الله تبارك وتعالى يوفِّقُ من يشاءُ ويخذلُ من يشاءُ فيكون الذين وفَّقَهم من أهلِ النَّعيمِ المقيمِ في الآخرةِ ويكون الذين لم يوفّقهم بل خَذَلهم من أهلِ العذابِ المقيمِ.
وليَعلم العاقلُ أن أمرَ الدّينِ لا يتمُّ إلا بالتّسليمِ لله أمّا أن يقاسَ الخالقُ على المخلوقِ فهذا ضلالٌ وخُسرانٌ.
قال المؤلّف رحمه الله: وصَحَّ حديثُ: "فمنْ وجَدَ خَيْرًا فليحمَدِ الله ومنْ وجدَ غيرَ ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسَه" رواه مسلمٌ منْ حَديثِ أبي ذرّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عَن الله عزَّ وجلَّ.
الشرح: هذا الحديثُ أيضًا صحيحٌ عن رسولِ الله ومعناهُ من عَمِلَ الحسناتِ والطّاعاتِ وتجنّبَ المعاصي فليحمَدِ الله الذي وَفَّقَهُ لذلكَ، ومن وَجَدَ غيرَ ذلك أي من كان عملهُ خلافَ ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَهُ، أي أن الله ليسَ ظالمًا له ولكن هو ظَلَمَ نفسَهُ، لا يقال لِمَ لَم يجعل كلَّ العبادِ طائعينَ كالملائكةِ لأنّهُ يفعلُ ما يريدُ، فمن قالَ ذلكَ اعتراضًا على الله يكفرُ، أمّا إذا قالَ ذلكَ واحدٌ ليعرفَ الحِكمَةَ فلا يكفُرُ.
قال المؤلّف رحمه الله: أمّا الأوَّلُ: وهو من وجدَ خيرًا فلأَنَّ الله تعالى متفضّلٌ عليه بالإيجادِ والتَّوفيقِ من غيرِ وجوبٍ عليه، فليَحمد العبدُ ربَّهُ على تفضُّلِه عليه.
أمّا الثاني: وهو من وجَدَ شرًّا فلأَنّهُ تعالى أبرزَ بقدرَتِهِ ما كانَ من ميلِ العبدِ السيّءِ فمن أضلَّهُ الله فبعدلِهِ ومن هَدَاهُ فَبِفَضلِهِ.
الشرح: من وفَّقهُ الله لفعلِ الخيراتِ فليحمَد الله، وأمَّا العبدُ المخذولُ الذي ابتُلِيَ بالمعاصي فلا يلومنَّ إلا نفسَهُ.
والله أظهرَ من العبدِ الكافرِ ما سبقَ في علمِهِ الأزليّ أن هذا الإنسانَ مائلٌ إليهِ، فَقَبلَ أن يفعلَ هذا العبدُ كانَ مُستعدًّا والله أظهرَهُ.
قال المؤلّف رحمه الله: ولو أنّ الله خلقَ الخلقَ وأدخَلَ فريقًا الجنَّةَ وفريقًا النَّارَ لسابِقِ علمِه أنّهم لا يؤمنونَ لكانَ شأنُ المعَذَّبِ منهم ما وصفَ الله بقولِه: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى﴾ [سورة طه/134].
الشرح: لو كانَ الله لم يبعث الرسلَ إلى عبادِهِ ليبيّنوا لهم ما هو الخيرُ وما هو الشرُّ ثمّ عاقَبَهم على عملِهم السّوءَ لقالوا: لولا أرسلتَ إلينا رسولا أي لِمَ لم ترسل إلينا رسولا نتّبعهُ، فقطعَ الله عليهم العذرَ بأن أرسلَ الأنبياءَ، فالأنبياء وظيفتُهم أن يبيّنوا ما حَرَّمَ الله ويبيّنوا ما هو فرضٌ على العبادِ مطلوبٌ منهم طلبًا جازمًا أن يفعلوهُ، هذا وظيفةُ الأنبياءِ، ثم الله لو لم يرسل رُسلًا فعذَّبَ من شاءَ لم يكن ظالمًا لكنّه أرسلَ الرُّسُلَ فقطعَ العذرَ على الكافرينَ.
قال المؤلّف رحمه الله: فأَرْسَلَ الله الرسُلَ مُبَشّرينَ ومُنذرِينَ ليُظْهِرَ ما في استِعْدادِ العَبْدِ مِنَ الطَّوْعِ والإبَاءِ فَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بيّنةٍ ويَحْيَا مَنْ حَيَّ عن بَيّنَةٍ.
الشرح: لمّا أرسلَ الله الرّسلَ فبيّنوا للنّاسِ ما أَمرَهُم الله أن يفعلوهُ ولا يتركوهُ وما حرَّمَ عليهم ثمّ اهتدى من اهتدَى وضلَّ من ضلَّ، كان الذين اهتدوا اهتدوا عن بيّنةٍ والذين ضلّوا ضلّوا عن بيّنةٍ أي عن دليلٍ وعن حُجَّةٍ.
قال المؤلّف رحمه الله: فأَخْبَرَنَا أنَّ قِسْمًا مِنْ خَلْقِه مَصِيْرُهُمُ النّارُ بأعْمالِهِمُ التي يَعْملُونَ باخْتِيَارِهم، وكانَ تَعالى عَالِمًا بعِلْمهِ الأزَليّ أنَّهُم لا يُؤمنُونَ.
الشرح: الله تعالى عَلِمَ بعلمِهِ الأزليّ مَن يؤمن ومَن لا يؤمنُ، مَن يقبَلُ مِنَ الأنبياءِ ومَن لا يقبَلُ، فَثَبَتَت الحُجَّةُ على عبادِهِ.
قال المؤلّف رحمه الله: قالَ تَعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة السجدة/13] أخْبَرَ الله تَعالى في هذِه الآيةِ أنَّهُ قالَ في الأزلِ: ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (13) وقَوْلُه صِدْقٌ لا يَتَخَلَّفُ لأنَّ التّخلُّفَ أي التّغيُّرَ كذِبٌ والكذِبُ مُحالٌ على الله.
الشرح: المعنى لو شاءَ الله في الأزلِ أن يهتدِيَ جميع الأنفسِ لاهتَدَى جميع الأنفسِ، لأَعطى لكلّ نفسٍ هُدَاهَا وجعلَها مؤمنةً مهتديةً، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ (13) أي ولكن قلتُ في الأزلِ وقولي لا يتخلفُ: ﴿لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (13) أي أنّني سَأملأُ جهنّمَ من الجنّ والإنسِ، معناهُ الله تعالى قالَ في الأزلِ إنه يملأُ جهنمَ من الجِنةِ والناسِ فلا بُدَّ أن تُملأَ جهنمُ من كفار البشرِ والجنِ. قَدَّمَ ذِكرَ الجِن لأن أكثرَ أهلِ النارِ من الجنِ. وقولُ الله صدقٌ لا يتخلَّفُ أي لا يتغيّرُ، أليسَ قالَ في الأزلِ إنَّ قسمًا من العبادِ من الإنسِ والجنِّ يُدخلهم جَهنَّم وإنّ قسمًا يكونونَ من أهلِ الجنّةِ فلا يتغيّرُ الأمرُ، فلا يجوزُ أن يقالَ: لو قالَ ذلكَ في الأزلِ فهو قادرٌ على أن يغيّرَ الأمرَ، ولا يقالُ: يفعلُ ما يشاءُ فيبدّلُ قولَهُ، لأنَّ الخُلفَ في قولِ الله مستحيلٌ، وذلك في الوعدِ والوعيدِ.
فما أخبرَ الله أنه يفعلهُ فلا بدَّ أن يفعلهُ وما أخبرَ أنه لا يفعلهُ فلا يكون، وما قالهُ بعضٌ من خِلافِ هذا فهو مردودٌ، وذلك البعضُ أرادَ أن يجعلَ وعيدَ الله كوعيدِ الخلقِ واستدلَّ هذا البعضُ بقولِ الشاعر:
وإني وإن أوعدتهُ أو وعدتُهُ لَمُخْلِفُ إيعادي وَمُنْجِزُ موعدي
فالشاعرُ قال ذلك في حق نفسِهِ وهو خَلقٌ من خَلقِ الله فلو أوعَدَ وأخلفَ فلا يعدُّ عيبًا، وأما الله تعالى فيجبُ تحقق كلامه في الإيعادِ والوعدِ.
وأما قول كثيرٍ من الجهلةِ: الله قادرٌ أن يُغيرَ ما قالَ في مثل هذا فهو كفرٌ، يقالُ لهم: الله قادرٌ على كل شىءٍ لكن لا يُخلِفُ في قولِهِ لأن الإخلافَ في قولِهِ كذبٌ والله منزهٌ عن الكَذبِ، فليس هذا من وظيفةِ القدرةِ، فما أشنعَ قول بعضٍ: "الله قادرٌ أن يشيلَ أهلَ النار ويحطهم في الجنةِ" قاصدًا بذلك جميعَ أهلِ النارِ من الكفارِ وجميع عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة وكذلك من قال ذلك في بعض الكفار لأن الله أخبر أن الكفار لا يخرج أحد منهم من جهنم، يقال لهؤلاء: أنتم نسبتُم إلى الله الكذبَ وأنتم لا تشعرونَ، ويقالُ لهم: هو قادرٌ لكنه لا يفعل لأنه يلزمُ من ذلك نسبة الكذبِ إلى الله، لأن الله أخبرَ بأن الكفارَ لا يخرجونَ منها كلما أرادوا أن يخرجوا رُدّوا إليها. والفرق بين الكفار وبين عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة أن عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة بعضهم يدخلون النار جزاء لهم على ذنوبهم وبعضهم لا يدخلهم الله النار فضلًا منه. الله تعالى ينقذ بعض هؤلاء من النار فلا يدخلهم مهما بلغت ذنوبهم ولا يلزم في ذلك الخلف في كلام الله لأنه لم يقل فيما أوحى به إلى الأنبياء إنه لا بد أن يُدْخِلَ كل عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة بل أخبر تبارك وتعالى بأنه يغفر لمن لم يكفر بالإشراك أو غيره من أنواع الكفر يغفر لهم فلا يدخلهم النار وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ [سورة النساء/116] ودل على ذلك الحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب" قيل وما يقع الحجاب يا رسول الله قال: "أن تموت النفس وهي مشركة" رواه ابن حبان وغيره. ومثل الشرك سائر أنواع الكفر، فلا يغفر الله للكافر المشرك والكافر غير المشرك، فالكافر المشرك هو الذي يعبد غير الله والكافر غير المشرك كمن يسب الله أو رسولا من رسل الله أو يسب ملكًا من الملائكة أو يسب شيئًا من شعائر الإسلام كالصلاة والصيام، أو ينكر ما أثبته الله في شرعه، أو ينفي ما أثبت الله أو غير ذلك من أنواع الكفر مما ذكره الفقهاء في مؤلفاتهم. وذكروا لذلك قواعد وقد أكثر بيان ذلك صاحب كتاب أنوار أعمال الأبرار في الفقه الشافعي، والأكثر توسعًا في ذلك فقهاء المذهب الحنفي كالإمام بدر الرشيد فإنه أفرد لذلك تأليفًا.
قال المؤلّف رحمه الله: قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة الأنعام/149] أيْ ولكنَّهُ لم يشَأ هِدَايةَ جَمِيعِكُم إذْ لم يَسْبِق العِلْمُ بذَلِكَ.
الشرح: الله له الحجّةُ التّامَّةُ فلو شاءَ في الأزلِ أن يهتديَ الجميعُ لاهتدوا ولكنّهُ لم يشأ هدايةَ الجميعِ إذ لم يسبق العلمُ بذلكَ. ثمّ هؤلاءِ الكفّارُ لو رُدّوا إلى الدُّنيا لعادوا إلى ما كانوا عليهِ ولو عادوا لعَادَ إليهم ذلكَ الميلُ.
قال المؤلّف رحمه الله: فالعِبادُ مُنْسَاقُونَ إلى فِعْلِ ما يَصدُرُ عَنْهُم باختِيارِهم لا بالإكرَاهِ والجَبْرِ.
الشرح: الخلقُ منساقونَ إلى ما شاءَ الله تعالى في الأزلِ وعَلِمَ أنّهم يفعلونَ، لا بدَّ أن ينساقوا إليه باختيارِهم، المؤمنونَ الذين ءامنوا ينساقونَ إلى الإيمانِ باختيارِهم، والكفّارُ الذين شاءَ الله تعالى أن يموتوا كافرينَ انساقوا إلى الكفرِ باختيارِهم، فتَنَفَّذَت مشيئةُ الله في هؤلاءِ وهؤلاءِ.
فالعبادُ لهم اختيارٌ في أفعالِهِم الاختياريَّةِ ولكنّهم ليسوا خالقينَ لأفعالِهِم، وكذلك ليسوا كالرّيشةِ المعلَّقَةِ في الهواءِ تأخُذُها الرّياحُ يمنةً ويسرةً بلا اختيارٍ منها، فتسويةُ هؤلاءِ بين العبادِ وبين تلك الريشة إلحادٌ وكفرٌ.
قال المؤلّف رحمه الله: واعْلَمْ أنَّ مَا ذَكَرنَاهُ منْ أَمْرِ القَدَرِ لَيْسَ مِنَ الخَوْضِ الذي نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْهُ بقولِه: "إذَا ذُكِرَ القَدَرُ فأَمْسِكُوا" رَواهُ الطَّبَرانيُّ، لأنَّ هَذَا تفسِيرٌ للقَدَرِ الذي ورَدَ بهِ النَّصُّ، وأَمَّا المنْهِيُّ عَنْهُ فَهُو الخَوْضُ فِيه للوُصُولِ إلى سِرّهِ، فَقَد رَوَى الشَّافِعيُّ والحافِظُ ابنُ عسَاكِرَ عن عليّ رَضِيَ الله عَنهُ أنَّهُ قَالَ للسَّائِلِ عَن القَدَرِ: "سِرُّ الله فلا تَتَكَلَّفْ"، فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ قَالَ له: "أَمَّا إذْ أبَيْتَ فَإنَّهُ أمْرٌ بَيْنَ أمْرَيْنِ لا جَبْرٌ ولا تَفْوِيضٌ".
الشرح: قولُهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأمسكوا" معناهُ لا تَتَوغَّلوا في البحثِ والخوضِ فيه للوصولِ إلى سِرّهِ، هذا مُنعنا منه لأَنّهُ بحرٌ ليسَ له سفينة، أمّا تفسيرُ القَدَرِ الذي مَرَّ يجبُ معرفتُهُ، فأصلُ القدرِ سِرّ الله تعالى في خلقِهِ لم يَطَّلع على ذلكَ مَلَكٌ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسَلٌ، ومهما تكلَّفَ بعضُهم الخوضَ في ذلكَ للوصولِ إلى سِرّ القَدَرِ فلن يستطيعوا لأنّ الله أخفَى عنَّا ذلكَ ونهانا عن طلبِهِ.
وقولُ عليّ رضي الله عنه: "لا جبرٌ ولا تفويضٌ" يريدُ به أنّ عقيدةَ أهلِ السّنةِ والجماعةِ هي أنَّ العبدَ له اختيارٌ ممزوجٌ بجبرٍ وأنَّ العبدَ مختارٌ تحتَ مشيئةِ الله وأنّنا لا نقولُ بمقالةِ الجبريّةِ القائلينَ بأنّ العبدَ لا فعلَ له بالمرّةِ وإنّما هو كالرّيشةِ المعلّقةِ في الهواءِ تأخذُهَا الرّياحُ يمنةً ويسرةً، ولا نقولُ بمقالةِ المعتزلةِ القائلينَ بأنّ العبدَ يخلُقُ أفعالَهُ، إنّما نحنُ وسطٌ بين الجبرية والقدرية أي المعتزلة. ولا تقالُ هذه العبارة: الإنسانُ مسيَّرٌ أم مخيَّرٌ فهذه الكلمةُ غلطٌ لغةً وشرعًا فالناسُ مسيرونَ بمعنى أن الله يمكنهم من السيرِ في البَرّ والبحرِ قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [سورة يونس/22] معناه الله تعالى هو الذي يمكنكم من السير هو الذي يخلقُ فينا الحركةَ الاختياريةَ والحركةَ غير الاختياريةِ، بل يقالُ العبدُ مختارٌ تحتَ مشيئةِ الله. المختارُ من الاختيارِ، أمَّا مخيَّرٌ فمن التَّخييرِ أي الذي يُخيَّرُ بينَ أمرينِ ونحو ذلك فالتّخييرُ هنا لا معنَى لهُ وما أكثر من يلهج بذلك من أدعياء العلم.
قال المؤلّف رحمه الله: واعْلَم أيضًا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ ذَمَّ القَدَرِيّةَ وهُمْ فِرَقٌ، فمِنْهُم مَنْ يَقُولُ: العبدُ خَالِقٌ لجمِيْع فِعْلِه الاخْتِيَاريّ، ومنْهُم مَنْ يَقُولُ هُوَ خَالقُ الشّرّ دُونَ الخيْرِ وكِلا الفرِيقيْنِ كفّارٌ، قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ" وَفي رِوايةٍ لهذَا الحديثِ: "لِكُلّ أمَّةٍ مَجُوسٌ، ومَجُوسُ هذِهِ الأُمَّةِ الذينَ يَقُولونَ لا قَدَرَ" رَواهُ أبُو داودَ عنْ حُذَيفَةَ عنِ النّبي صلى الله عليه وسلم.
الشرح: هذانِ الحديثانِ فيهما دليلٌ على أنَّ المعتزلةَ القائلينَ بأنَّ العبدَ يخلُقُ أفعالَهُ الاختياريّةَ أو أنّه خالقُ الشَّر دونَ الخيرِ كُفَّارٌ. وقد جَاءَ عن سيدنا علي رضي الله عنه أنهُ قالَ: "إنَّ المجوسَ كانَ لهم كتابٌ وعلمٌ يدرسونَهُ"، أي كانوا على الإسلامِ لهم كتابٌ سماويٌّ وعلمٌ يدرسونَهُ، "ثمَّ ملكهم شَرِبَ الخمرَ فَسَكِرَ فوقَعَ على أختِهِ، ثمَّ لمَّا صَحَا تسامَعَ بأمرِهِ النّاسُ، فعلمَ بذلكَ فجمعَ رؤساءَ من رعيّتِهِ، فقالَ لهم: نحنُ أولى أم ءادم أولى، ءادمُ كانَ يزوّجُ بنيهِ من بناتِهِ فلا يجوزُ لنا أن نُسَفّهَ ما كانَ عليه ءادم، فبعضهم خالفوهُ وأنكروا عليه وبعضهم وافقوهُ فرضيَ عنهم وعذَّبَ الآخرينَ فقتلَ من قَتَلَ منهم حتَّى مشَى رأيه هذا. قالَ سيّدنا عليّ: "فلمَّا فعلوا ذلك أُسرِي بكتابِهم" يعني رُفِعَ من بينهم وفقدوه، وأُخِذَ من قلوبهم ذلك العلمُ الذي كان فيهم وهو علمُ الإسلامِ فبقوا على عبادةِ النَّارِ، إلى الآن أحدُهم إذا سافرَ لمَّا تُشعَل الكهرباءُ في المساءِ يعبدُها ويتوجَّهُ لها.
قال المؤلّف رحمه الله: وفي كِتَابِ "القَدَرِ" للبَيهقِيّ وكتابِ "تَهذيب الآثَار" للإمامِ ابنِ جَريرٍ الطَّبَريّ رحمهُما الله تعالى عن عبدِ الله بنِ عمرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صِنْفَان من أُمَّتي ليسَ لَهُما نَصِيبٌ في الإسْلامِ القَدَرِيَّةُ والمرجئَةُ" فالمعتزلةُ همُ القَدَرِيّةُ لأنَّهُم جَعلُوا الله والعَبدَ سَواسِيَةً بنَفْيِ القُدْرَةِ عَنْهُ عزَّ وجَلَّ على مَا يُقْدِرُ علَيه عَبْدَه، فَكأنَّهُم يُثْبتُونَ خَالِقِيْنَ في الحَقِيقةِ كَمَا أَثْبتَ المجُوسُ خَالِقَيْنِ خَالِقًا للخَيْرِ هوَ عندَهُم النّورُ وخالقًا للشّرّ هو عندَهُمُ الظَّلامُ.
الشرح: هذا الحديثُ فيه دليلٌ على أنّ كلًّا من هذينِ الفريقينِ كُفَّارٌ، أمّا المعتزلةُ فقد مرَّ بيانُ حالِهم وهم نحو عشرينَ فرقةً منهم من وَصَلَ إلى حَدّ الكفرِ كالذين ذكرناهم ومنهم من لم يَصِل إلى ذلكَ الحَدّ بل اقتصروا على قول إن الله لا يُرى في الآخرة كما لا يُرى في الدنيا وقولهم إن مرتكب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن يخلّد في النار بلا خروج وقولهم إنه لا شفاعة لبعض عصاة المؤمنين من الأنبياء والعلماء والشهداء، فمن وافق المعتزلة في هذا ولم يوافقهم في قولهم إن العبد يخلق أفعاله استقلالا بقدرة أعطاه الله إياها ولا في قولهم إن الله شاء أن يكون كل العباد طائعين ولكنّ قسمًا منهم كفروا وعصوا بغير مشيئته فلا يكفر.
وأمّا المرجئةُ فهم طائفةٌ انتسبوا للإسلامِ كانوا يعتقدونَ أنَّ العبدَ المؤمنَ مهما عَملَ من الكبائرِ وماتَ بلا توبةٍ ليسَ عليه عذابٌ. قالوا لا يضرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ كما لا ينفعُ مع الكفرِ طاعةٌ، قاسوا هذه على هذه فضَلّوا وهَلَكوا، لأنَّ قولهم: "لا ينفعُ مع الكفرِ طاعةٌ" صحيحٌ لأنَّ الكافرَ مهما قامَ بصورِ أعمالِ الطاعةِ وهو على كفرِهِ لا ينتفعُ بذلكَ، وأمّا قولُهم: "لا يضرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ لمن عَمِلَهُ" فهو كفرٌ وضلالٌ لأنَّ المؤمنَ ينضرُّ بالمعاصي التي يرتكبها، والإرجاءُ معناه التّأخيرُ، وإنّما سُمّوا بالمرجئةِ لأنّهم أَخَّروا عنهم العذابَ، أي قالوا لا يصيبهم العذابُ أي لمن عَصوا وَهُم على الإيمانِ، معناهُ الإيمانُ يؤخّرُ عنهم العذابَ أي لا يلحقهم العذابُ.
والسّببُ في هلاكِهم في هذه المسئلةِ أنّهم فَهِموا بعض الآياتِ على غيرِ وجهِهَا كقولِه تعالى: ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ﴾ [سورة سبإ/17] فظنّوا أنَّ غَيرَ الكافرِ لا يعذّبُ، إنما معنى الآية أنَّ ذلكَ العذاب الذي ذُكِرَ لا يلقاهُ إلا الكفورُ. هؤلاءِ ولله الحمدُ كأنَّهم انقرضوا منذ زمانٍ ما بَقِيَ منهم أحدٌ فيما نعلمُ إنَّما لهم ذِكرٌ في كُتُبِ الاعتقادِ.
تِتِمّة: المعتزلة يعتقدون جملة من العقائد شذُّوا فيها عن أهل السنة منها قولهم بأن الله ما شاء حصول المعاصي والشرور وإنما يحصل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله، ومنها قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أعطاه الله إياها وليس الله يخلقها يقولون إن الله كان قادرًا على أن يخلق حركات العباد وسكناتهم قبل أن يعطيهم القدرة عليها فبعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجزًا، ومنها قولهم بنفي صفات الله تعالى من علم وقدرة وحياة وبقاء وسمع وبصر وكلام فهم يقولون الله عالم بذاته لا بعلم، قادر بذاته لا بقدرة، حي بذاته لا بحياة وهكذا في سائر الصفات. وهذه الأقوال الثلاثة يجب تكفيرهم بها ولا يجوز أن يقال إنهم لا يكفَّرون بها وإن كانوا يفسَّقون بها ويبدَّعون من غير أن يصلوا إلى حدّ الكفر كما قال عدد من متأخري الشافعية والحنفية فإن هؤلاء المتأخرين خالفوا ما نصَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة لا يُعرف بينهم مخالف فيه وهذا هو قول سلف الأمة فهو القول الصحيح المعتمد وما خالفه مردود على قائله لأنه لا يجوز أن يُترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أصحابه بلا خلاف لقولٍ مستحدث مخالف بل مَنْ خالف في ذلك ينطبق عليه حديث مسلم مرفوعًا: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" اهـ.
ولذلك اعتمد المحققون من الخلف القول بتكفيرهم ولم يرتضوا قولا سواه، وإليك زيادة بيان ما قدمناه.
فأما الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن ابن الديلميّ عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لو عذَّب أهل أرضه وسمواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رَحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم ولو أنفقتَ مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مِتَّ على غير هذا دخلت النار" اهـ.
وروى أبو داود عن ابن عمر مرفوعًا: "القدرية مجوس هذه الأمة" اهـ وعنده من طريق حذيفة مرفوعًا كذلك "لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر" اهـ. وهذا الحديث مشهور يحتج به في العقيدة ولذلك احتج به الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله الخمس.
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام القدرية والمرجئة" اهـ والقدرية هم المعتزلة. والحديث رواه ابن جرير الطبري وصححه. ورواه البيهقي من أكثر من طريق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن زرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (48) ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (49) [سورة القمر] قال "نزلتْ في أناس من أمتي يكونون في ءاخر الزمان يكذّبون بقدر الله" اهـ.
وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أبي هريرة قال جاءت مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ﴾ ﴿47﴾ إلى قوله ﴿خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (49) اهـ.
وروى البيهقي عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيرهم وأنهم يكونون أتباع الدجال عند ظهوره.
فهذه الأحاديث كلها تدل على كفر نفاة القدر القائلين بأن العبد يفعل بغير مشيئة الله، ولهذا لم يختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كفرهم.
روى البيهقي في كتاب القدر بالإسناد الصحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن رجلًا من أهل الذمة قال أمامه في الجابية "إن الله لا يضل أحدًا" فغضب عمر وقال: "كذبتَ يا عدو الله ولولا أنك من أهل الذمة لضربتُ عنقك هو أضلك وهو يدخلك النار" اهـ.
وروى البيهقي في كتاب القدر أيضًا عن سيدنا عليّ رضي الله عنه أنه قال: "إن أحدكم لن يَخْلص الإيمانُ إلى قلبه حتى يستيقن يقينًا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليُصيبه ويُقِرَّ بالقدر كله" اهـ.
وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن ابن الديلميّ عن أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت قولهم: "لو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار" اهـ وقد تقدم في غير موضع.
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح قال أتيتُ ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له: قد تُكُلم في القدر، فقال: أوفعلوها، قلت: نعم، قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (48) ﴿إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (49) أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلّوا على موتاهم إن رأيتُ أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعيّ هاتين اهـ.
ورُوي عنه أيضًا قوله: كلام القدرية كفر اهـ وقد تقدم.
وقد أُخْبِرَ ابنُ عمر رضي الله عنهما أيضًا بحدوث القول في القدر في العراق على مقتضى كلام المعتزلة فقال للمُخْبِرِ وكان يحيى بن يعمر من أجلَّاء التابعين: أخبرهم بأني بريء منهم وأنهم برءاء مني والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبًا ما قُبِلَ ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره اهـ. رواه مسلم.
وروى البيهقي في كتاب القدر عن لبيد قال: سألت واثلة بن الأسقع عن الصلاة خلف القدري فقال: لا تصلّ خلف القدري أما أنا لو صليت خلفه لأعدت صلاتي اهـ.
وروى البيهقي عن سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: والله ما قالت القدرية بقول الله ولا بقول الملائكة ولا بقول النبيين ولا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول صاحبهم إبليس اهـ وقد تقدم.
وأما التابعون فمنهم ابن الديلميّ كما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقد ذكر حديثه ءانفًا.
ومنهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمهبهن الحميري. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وهما سمعا حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور ءانفًا.
ومنهم أبو سهيل عمُّ الإمام مالك وعمرُ بن عبد العزيز رضي الله عنهما فقد روى البيهقي في القدر عن أبي سهيل أنه قال: كنت أمشي مع عمر ابن عبد العزيز فاستشارني في القدرية فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي، قال مالك: وذلك رأيي اهـ.
ولعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رسالة مشهورة في الرد على القدرية، رواها أبو نعيم وغيره.
ومنهم التابعي الجليل محمد بن سيرين، فقد روى البيهقي عنه أنه قال: إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في ءايات الله فلا أدري من هم اهـ.
ومنهم الحسن البصري فقد روى ابن عساكر في تاريخه عن عاصم قال سمعت الحسن البصري يقول: من كَذَّبَ بالقدر فقد كذّب بالحق إن الله تبارك وتعالى قدّر خلقًا وقدر أجلًا وقدّر بلاء وقدّر مصيبة وقدّر معافاة فمن كَذَّبَ بالقدر فقد كذب بالقرءان اهـ.
وأفتى الزُّهْرِيُّ عبدَ الملك بن مروان بدماء القدرية كما ذكره الإمام عبد القاهر التميمي في أصول الدين.
ولعنهم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي عن عكرمة بن عمار أنه قال سمعت سالم بن عبد الله يلعن القدرية اهـ.
ومن أتباع التابعين صرَّحَ بكفرهم جماعة كبيرة منهم الإمام مالك بن أنس فقد روى البيهقي عن إسحاق بن محمد الفروي أنه قال سئل مالك عن تزويج القدري فقال: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ﴾ [سورة البقرة/221] اهـ.
ومنهم الإمام أبو حنيفة كما صرَّح في بعض رسائله وقد قال: الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين يقال لهم: هل عَلِمَ الله ما يكون من العباد قبل أن يفعلوا، فإن قالوا لا كفروا لأنهم جَهَّلُوا ربَّهم، وإن قالوا عَلِمَ يقال لهم: هل شاء خلاف ما عَلِمَه، فإن قالوا نعم كَفَروا لأنهم قالوا شاء أن يكون جاهلًا، وإن قالوا لا رجعوا إلى قولنا اهـ. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: القدري إذا سلّم العلم خُصِمَ اهـ.
وقد كفّر الشافعيُّ حفصًا الفرد من رؤوس المعتزلة وقال له: لقد كفرتَ بالله العظيم اهـ رواه البيهقي في مناقب الشافعي.
وأما تكفير أحمد بن حنبل لهم فمعروف مشهور عنه رواه عددٌ منهم البيهقي وابن الجوزي وغيرهما.
وروى البيهقي في الأسماء والصفات تكفير أبي حنيفة وأبي يوسف لهم بل قال أبو يوسف فيهم: إنهم زنادقة اهـ.
ومنهم سفيان الثوري كما روى البيهقي عن أحمد بن يونس أنه قال سمعت رجلًا يقول لسفيان الثوري: إن لنا إمامًا قدريًّا قال: لا تقدِّموه، قال: ليس لنا إمام غيره، قال: لا تقدِّموه اهـ.
ومنهم سفيان بن عيينة، روى البيهقي عن أيوب بن حسان أنه قال سئل ابن عيينة عن القدرية فقال: يا ابن أخي قالت القدرية ما لم يقل الله عزَّ وجلَّ ولا الملائكة ولا النبيون ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس... إلخ اهـ.
ومنهم محمد الباقر بن عليّ زين العابدين كما روى البيهقي عن الحارث بن شريح البزار قال قلت لمحمد بن علي: يا أبا جعفر إن لنا إمامًا يقول في هذا القدر، فقال: يا ابن الفارسي انظر كل صلاة صليتها خلفه فأعدها، إخوان اليهود والنصارى قاتلهم الله أنى يؤفكون اهـ.
ومنهم الإمام المجتهد أبو عمرو الأوزاعي فإنه كفَّر غيلان القدري وقال لهشام بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اهـ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بروايات عدة.
ومنهم الحافظ يحيى بن سعيد القطان فقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن سعيد بن عيسى الكُزبري يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: شيئان ما يخالج قلبي فيهما شك تكفير القدرية وتحريم النبيذ اهـ.
ومنهم إبراهيم بن طهمان كما روى البيهقي عن الحسن بن عيسى أنه قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية والقدرية كفار اهـ.
فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم فقهاؤهم وعلماؤهم عمرُ وعليٌّ وأبيّ وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس مجمعة على تكفير القدرية لم يخالفهم في ذلك صحابيّ واحد، ومعهم على هذا مشاهير علماء التابعين كابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن شهاب الزهري، وتبعهم على ذلك أتباع التابعين وبينهم المجتهدون أصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومع هؤلاء كلهم أئمة أهل البيت عليّ والحسين والباقر رضوان الله عليهم فكيف بعد هذا كله يجرؤ بعض المتأخرين على الزعم بأن القول المعتمد تركُ تكفير المعتزلة القائلين بخلق العبد لأعماله وبنفي صفات الله تعالى وبأي لسان يزعم منتسب إلى الإسلام بأن القول بعدم تكفيرهم الذي يخالف الأحاديث الصريحة وإجماع الصحابة وأقوال أئمة المجتهدين من التابعين وأتباعهم هو القول المعتمد. وإذا كان هؤلاء كلهم أخطأوا الصواب ولم يفرقوا بين الكفر والإيمان على ما يقتضيه كلام هؤلاء المتأخرين فمِنْ أين عرفوا هم الصواب بزعمهم في المسئلة ومن أي طريق بلغهم حكمها.
بل الحق ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصواب ما أجمع عليه الصحابة وقاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين، وأما ما خالف ذلك مما قاله بعض من جاء بعد هؤلاء بمئات من السنين كالباجوريّ أو الشربيني أو الأشخر ممن يُعَدّ في الأصول والفروع كالأطفال بالنسبة لهؤلاء الأساطين فيُضرب به عرض الحائط ولا يقام له وزن.
ولذلك لم يعتبر أئمة الخلف ومحققوهم هذا الرأي الشاذ بل جزموا بكفر المعتزلة ونقل الإمام أبو منصور التميمي البغدادي كفرهم عن الأئمة في كتابه أصول الدين، وقال في تفسير الأسماء والصفات: أجمع أصحابنا - أي أئمة الأشاعرة والشافعية - على تكفير المعتزلة اهـ.
وكفَّرهم إمام الهدى أبو منصور الماتريدي في كتابه التوحيد وعليه جرى أئمة الحنفية. قال الزبيدي في شرح الإحياء: إن مشايخ ما وراء النهر لم يتوقفوا عن تكفير المعتزلة اهـ وممن نصّ على ذلك منهم نجم الدين منكوبرس شارح الطحاوية.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكيّ من أصول الإيمان القدر من كذّب به فقد كفر. نص عليه مالك فإنه سئل عن نكاح القدرية فقال: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (221) اهـ.
وكفَّرهم الفقيه اللغوي شيث بن إبراهيم المالكي وألف في الرد عليهم كتاب "حز الغلاصم وإفحام المخاصم" وهو مطبوع.
وسئل الجنيد رضي الله عنه عن التوحيد فقال: اليقين، ثم استفسر عن معناه فقال: إنه لا مكوّن لشىء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى اهـ.
وقال الفقيه الحنبليّ وليّ الله السيد عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية له: تبًّا لهم - أي للقدرية - وهم مجوس هذه الأمة جعلوا لله شركاء ونسبوه إلى العجز وأن يجري في ملكه ما لا يدخل في قدرته وإرادته، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا اهـ.
وكفَّرهم أبو حامد الأسفراييني من أصحاب الوجوه بين الشافعية ولم يصحح الصلاة خلفهم.
وقال الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعاني الشافعي في الأنساب في ترجمة الكعبي المعتزلي وقد كَفَرَت المعتزلة قبله بقولها إن الشرور واقعة من العباد بخلاف إرادة الله عزَّ وجلَّ ومشيئته اهـ ثم قال فزاد أبو القاسم الكعبي في الكفر فزعم أنه ليس لله عزَّ وجلَّ إرادة ولا مشيئة على الحقيقة اهـ.
ونقل النووي في الروضة عن الحنفية تكفير من قال أنا أفعل بغير مشيئة الله وأقرهم عليه اهـ.
وسبق نقل ما ذكره البلقيني في هذه المسئلة وردّه على من صحَّح الصلاة خلفهم.
فتلخص مما تقدم أن القول الصحيح المعتمد الذي لا يجوز العدول عنه هو تكفير المعتزلة بكل مسئلة من المسائل الثلاث المذكورة ءانفًا، ولله درُّ أبي القاسم العلويّ القائل فيما رواه البيهقي عن أبي يعلى حمزة ابن محمد العلوي يقول سمعت أبا القاسم عبد الرحمن بن محمد بن القاسم الحسني وما رأيت علويًّا - أي من ذرية سيدنا علي - أفضل منه زهدًا وعبادة يقول: المعتزلة قَعَدَةُ الخوارج عجزوا عن قتال الناس بالسيوف فقعدوا للناس يقاتلونهم بألسنتهم أو تجاهدونهم أو كما قال اهـ.